عصر النهضة: رؤية في عوامل إخفاق النهوض العربي
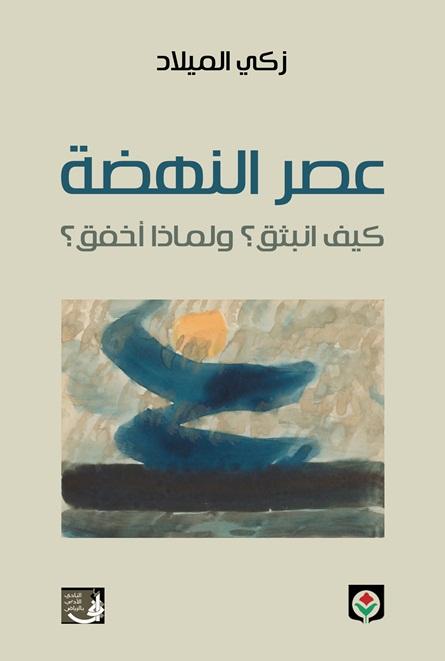
يقدم المفكر السعودي زكي الميلاد، في كتابه ”عصر النهضة: كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟“ قراءة نقدية للنهضة العربية من بداياتها إلى العصر الحالي، ويُعيد تقديم المشروعات الفكرية للنهضة العربية ويحلل أساب الفشل وتعثر النجاح، ويبحث في العلاقة بين المفاهيم التي تناولتها النهضة العربية، مثل التقدم والمدنية والهوية، بهدف إيجاد وعي نهضوي حداثي معاصر يفتح آفاقاً أمام المشروعات الحضارية العربية.
يعرض الميلاد وجهات نظر مغايرة لعصر النهضة العربي الأولى، باعتباره تحولاً تاريخياً مهماً، ووجهات نظر أخرى تراه يمثل تجارب نهضوية ناقصة؛ مؤكداً أن النهضة لم تكن مقتصرة على تلك المرحلة دون غيرها، فهي ما زالت إشكالية مطروحة في الفكر العربي المعاصر، رافضاً إرجاع إخفاق عصر النهضة إلى عامل خارجي، كالاستعمار، دون مراجعة العوامل الداخلية الثقافية والفكرية والاجتماعية التي تسببت في تعثر تجارب النهضة. ومن ثَم، يرى وجود أربعة تصورات مختلفة لكيفية انبثاق عصر النهضة، وهي:
- الحملة الفرنسية على مصر: ويراها الاحتكاك الأول والفعلي مع الحداثة الغربية، فمثلت صدمة أيقظت العرب من السبات التاريخي.
- حركة الإصلاح الديني: التي تمثلت في أعمال شخصيات محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.
- حركة التحديث الإدارية للدولة العثمانية: لا سيما في الولايات العربية مثل مصر والشام، وهي زاوية ترى النهضة نتاجاً للتحديث العثماني قبل الأوروبي.
- حركة الترجمة والتعليم والطباعة: التي أنتجت، في أوائل القرن التاسع عشر، تحولاً ثقافياً في المجتمعات العربية.
يقول المؤلف إن التصورات الأربعة لانبثاق النهضة العربية لا تتعارض، ويمكن النظر إليها بوصفها زوايا متعددة وأسباباً مختلفة للانبثاق النهضوي.
يوضح الكاتب أن الحملة الفرنسية مثلت لحظة مفصلية صدمت العالم العربي بالتقدم الأوروبي، وأظهرت فجوة حضارية كبيرة، لا سيما أن الحملة اصطحبت معها بعثة علمية تضم علماء ومهندسين ومطبعة حديثة، ما مثّل صدمة حضارية للمجتمع المصري، وأدى إلى تبلور أسئلة جديدة حول النهضة، مثل التقدم والهوية والذات والآخر. لكنه يؤكد أنه لا يمكن اعتبار الحملة الفرنسية الرافد الوحيد لعصر النهضة العربية، وينتقل إلى عبد الرحمن بن خلدون «1332-1406 م»، الذي يرى أن بعض المفكرين يعتبرون فكره يتسم بالنهضوية المبكرة، رغم أنه لم يتحول إلى مشروع إصلاحي عملي، موضحاً أن استدعاء بعض المفكرين لابن خلدون هدفه الدلالة على ”تفوق الماضي وتأكيد الذات الحضارية“، لكنه لا يمكن أخذه بعين الاعتبار ضمن مشروع نهضوي حديث، حسب قوله.
ويتحدث الميلاد عن دور جمال الدين الأفغاني «1838-1897 م»، فيرى أنه مثل نموذجاً مختلفاً عن الشخصيات الفكرية التقليدية؛ إذ كان مفكراً إصلاحياً وسياسياً ومثقفاً ناشطاً، جمع بين الإصلاح الديني وبين مقاومة الاستعمار والدعوة إلى وحدة إسلامية، وامتد تأثيره إلى تلاميذه وأهمهم محمد عبده «1849-1905 م»، وارتكز جهده الإصلاحي على محاور ثلاثة:
- الدعوة إلى نهضة عقلية تعتمد على العلم والتفكير.
- النهوض بالأمة عبر العودة إلى الروح الحية للإسلام.
- مواجهة الاستعمار ورفض التبعية للغرب.
ويقول المؤلف إن الأفغاني مثّل أحد ”الرموز المفتاحية“ لانبثاق النهضة، لكنه لم يؤسس مشروعاً نهضوياً متكاملاً، مؤكداً أن ارتباط النهضة العربية بالحملة الفرنسية لا يجب أن يحجب العوامل الذاتية والداخلية والتراكمات الفكرية والاجتماعية للنهضة، لا سيما أن النهضة العربية لم تكن نتيجة عامل منفرد أو لحظة واحدة، بل انبثقت بسبب عمليات متداخلة الأطراف والمراحل وكانت حراكاً فكرياً متعدد الاتجاهات. وبالتالي، يشدد على أهمية إعادة النقد وإعادة النظر في النهضة العربية، لأن العالم العربي ما زال يعيش توابع تلك المرحلة، داعياً إلى ضرورة فهم انبثاق النهضة وبداياتها حتى يمكن تجاوز إخفاقاتها.
يتناول الميلاد العلاقة بين الإسلام والمدنية، ويرى أن المدنية لا تعني التقدم العمراني فقط، بل تشمل التنظيم الاجتماعي والفكري والسياسي لعلاقات المجتمعات، ولمفاهيم مثل الحرية والعدالة. ويذهب إلى أن الإسلام، في بداياته، تفاعل مع مدنيات أخرى موجودة بالفعل لم يجد فيها تعارضاً معه، وتعامل معها على أنها مصدر للمعرفة والخبرة والتجربة، مثل حضارات الفرس واليونان والرومان والهند؛ لكن هذه الرؤية الإسلامية تراجعت في مراحل تاريخية لاحقة، فظهر الانغلاق والخوف من المدنيات الحديثة، الأمر الذي أدى إلى تأكيد بعض المفكرين الإصلاحيين، مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي، عدم تعارض الإسلام مع المدنية الحديثة وقيمها مثل العلم والعقل والاجتهاد.
ويرصد الكاتب ظهور تيار فكري بعد ذلك يهدف إلى إيجاد المدنية من داخل الإسلام ذاته، وربطه بالقيم الحديثة باعتبارها قيما إسلامية. إلا أن ارتباط المدنية بالإسلام، كما يؤكد الميلاد، شهد تراجعاً بسبب صعود التيار الأصولي ذي النزعة المغلقة، التي أعادت إنتاج خطاب مناهض للمدنية، وربطت العلمانية بالانحراف عن الدين.
ويجتهد الميلاد في الإجابة عن سؤال: ”لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟“، ويرى أن لهذا السؤال قيمة كبرى في إعادة النظر للواقع العربي، ويعرض لآراء كثير من المفكرين العرب في عصر النهضة والعصر الحديث، ويرى أن بعضهم رد التأخر لأسباب داخلية مثل الجهل وضعف التعليم وتعطيل الاجتهاد. ثم ينتقل إلى النقد المعاصر لسؤال تأخر المسلمين، ويرى أن عديداً من المفكرين العرب المُعاصرين قدم نقداً له، وطالب بضرورة تجاوزه إلى أسئلة أكثر فاعلية مثل ”سؤال البناء الحضاري“، و”سؤال الحداثة العربية“، و”سؤال الهوية في عالم العولمة“.
وينتقد الكاتب ربط سؤال التأخر بالمقارنة مع الغرب، الأمر الذي ”يضعف ثقة العرب بثقافتهم ويؤدي إلى اغتراب فكري وحضاري“، فيطالب بتحرير الفكر العربي من مركزية النموذج الغربي كمعيار أو مقياس للتقدم، وإعادة بناء المفاهيم النهضوية من داخل الخصوصية الحضارية الإسلامية، بما يستجيب لمتغيرات العصر ومتطلباته.
ينتقد الكاتب تركيز الفكر العربي على ”الهوية“، بدلاً من التركيز على مفهوم ”التقدم“، ويرى أهمية وضع قضية التقدم في مركز الفكر العربي، ويرى أن الاهتمام بالهوية كانت له أسباب، منها: الاختراق الثقافي الغربي، بعد مرحلة الاستعمار.. وفشل التجارب النهضوية ”العلمانية“ في تحقيق التنمية؛ ثم ظهور التيارات السلفية والجهادية، التي أعادت قراءة العلاقة مع الغرب من منظور صدامي.
ويشدد المؤلف على أهمية التركيز على مفهوم التقدم، أو على الأقل ربط الهوية بقضية التقدم في العالم العربي، ويرى أن الفكر الإسلامي الحديث شهد تحولاً نوعياً بين تيارين، هما:
- التيار الإصلاحي: الذي انفتح على مفاهيم الحداثة والمدنية والتجديد الديني.
- التيار الإحيائي: الذي ارتكز على الدفاع عن الهوية والتراث ومناهضة الحضارية الغربية.
يقول الميلاد إن الفكر العربي شهد اتجاهات نقدية لمشروعات النهضة، تمثلت في نقد الازدواجية من التراث، ونقد التبعية للغرب، وغياب البُعد المؤسسي في المشروعات النهضوية. ويرى أن مفكرين مثل محمد عابد الجابري «1935-2010 م»، وعبد الله العروي «1933 م»، وجورج طرابيشي «1939 م -2016 م»، وحسن حنفي «1935-2021 م»، سعوا إلى تفكيك المفاهيم التقليدية للنهضة لإعادة بنائها بمنهجيات علمية تحليلية جديدة.
ينتقد الكاتب الإسهامات الفكرية للمفكرين، أمثال: الجابري والعروي وطرابيشي وحنفي، ويرى أنها تعاملت مع النهضة على أساس أنها خطاب نخبوي، وتجاهلت السياقات الاجتماعية والسياسية، فبعضها رد إخفاقات المشروعات النهضوية إلى العوامل الخارجية من دون تحليل ”القصور الداخلي“، ما يدفعه إلى المطالبة بتجاوز ثنائية ”فشل ونجاح المشروع النهضوي“، مؤكداً على أهمية وضع تصور للنهضة كمشروع معرفي متجدد باستمرار.
كما ينتقد المشروعات الفكرية لكل من ألبرت حوراني «1915-1993 م»، الذي تناول النهضة عبر وجهة نظر ليبرالية؛ وبرهان غليون «1945 م»، الذي اهتم بعلاقة المثقف العربي بالحضارة الغربية عبر منظور نقدي حداثي؛ وفهمي جدعان «1939 م»، الذي قدم رؤية إصلاحية للتراث الإسلامي عبر مفاهيم التقدم، وذلك لأنهم رغم تقديمهم إسهامات مهمة في المشروع النهضوي، فإن مشروعاتهم الفكرية ظلت محددة وجزئية تفتقر إلى الأبعاد الأخرى النهضوية.
وختاماً، يُفكك المفكر السعودي زكي الميلاد، في كتابه ”عصر النهضة: كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟“، تجربة النهضة العربية من بداياتها إلى العصر الراهن، ويحلل أطروحاتها وبنياتها المعرفية ومراحل إخفاقاتها، ويرصد تحول الحركات الإصلاحية العقلانية إلى حركات إحيائية منغلقة تغلبت عليها التبعية الفكرية؛ مشدداً على أهمية تأسيس رؤية نقدية شاملة تجمع بين الأصالة والانفتاح، حتى يُمكن بناء مشروع حضاري متجدد يتجاوز الفشل ولا يكرر الأخطاء.
















