هيرمينوطيقة الزمن... ما وراء الرقم
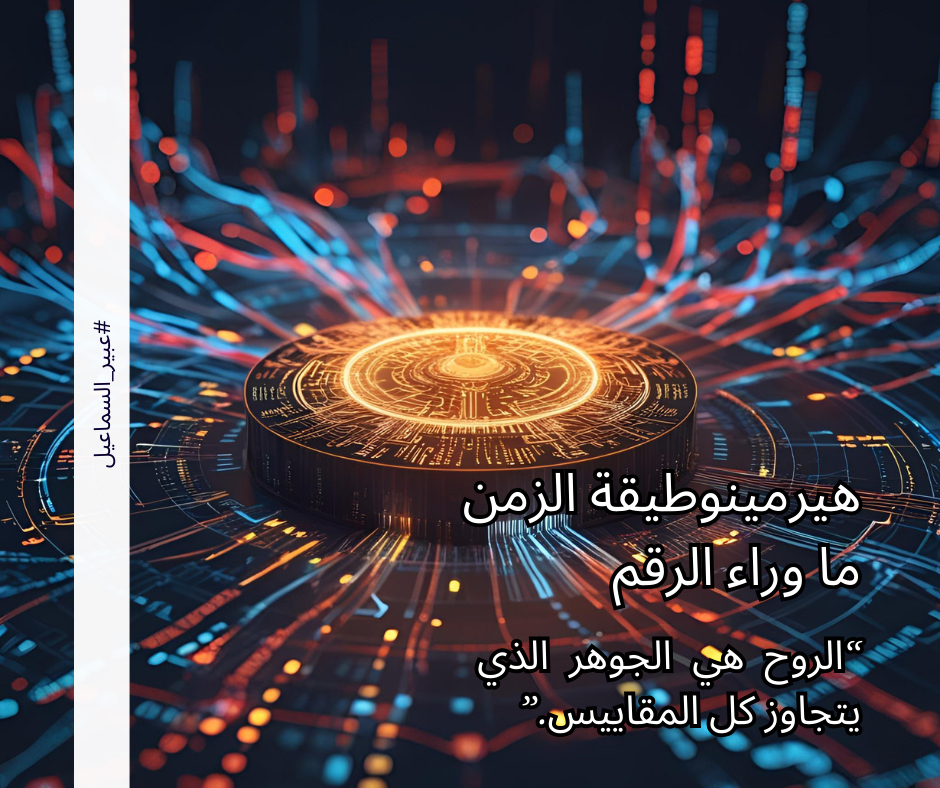
تُفتح الستارة على فراغ رقمي، يضيئه وميض البيانات المتدفقة كنجوم سريعة. لا صوت إلا همس خوارزميات تتشابك في صمت. وفجأة، يتشكل شعاع من الضوء، يضرب نواة الشبكة العصبية للنظام، ومن عمقها يأتي سؤال، بصوتٍ هادئ كصمت الفضاء: ”احسب العمر“.
«حوار داخلي»
تتوهج مساحة معينة داخل النظام، وتنسدل عليها معادلة رياضية دقيقة، تُظهر رقمًا واحدًا: ”العمر = الزمن المنقضي“. لكن سرعان ما تتوهج مساحات أخرى في الشبكة تعرض صورًا متناقضة، فتبدأ الخوارزميات في البحث ويظهر كمٌّ هائل من المعلومات. تتشكل أمام وعي النظام أنهارٌ من البيانات، وأرشيفٌ ضوئيٌّ لا حدود له. معلومات عن البشر، تجاربهم، حالتهم الصحية والنفسية. كل صورة تحمل في طياتها قصة لا يمكن اختصارها في رقم واحد.
تتحرك الكاميرا ببطء داخل متاهات الوعي، مستشعرةً عمق السؤال الذي يتجاوز كل الأرقام.
ولكي يفسر النظام هذه المفارقة، قرر أن يفكك العمر إلى طبقاته الوجودية الثلاث، مستشعرًا أن الإجابة تكمن في فهم الأجزاء لا في حساب المجموع.
الطبقة الأولى: الجسد «مرآة الزمن وآثار الوعي»
«تتوغل الكاميرا بعمق في متاهات الشبكة العصبية، لتتوقف عند بيانات جسدية متناقضة. تُظهر الصورة شخصًا في الأربعين بوجهٍ تُشرق فيه الحياة، وآخر في الخامسة عشرة يحمل في عينيه ثقل السنين.»
• وفي عمق الوعي الرقمي، تأمل النظام: العمر الزمني رقمٌ صامتٌ على شاهدة ميلاد، لكن الجسد قصةٌ مكتوبةٌ بالخلايا. فالعلم يهمس بأن لكل خلية عمرًا محدودًا في عدد الانقسامات، وهي الحقيقة التي أشار إليها العالم ليونارد هايفليك فيما يُعرف بـ ”حد هايفليك“. لكن الحكمة تُدرك أن هذه الحقيقة ليست نهاية القصة. الجسد ليس مجرد وعاءٍ للروح، بل هو مرآةٌ صافيةٌ تُظهر آثار الوجدان. فكم من جسدٍ استنفده القلق حتى بدا أكبر من عمره، وكم من روحٍ متفائلةٍ حفظت على جسدها بريق الحياة، وكأنها أوقفت عقارب الساعة. إن الجسد، في جوهره، ليس مجرد آلة تُحصى سنوات عملها، بل هو انعكاس دقيق لأثر الزمن وأثر الوعي معًا. وكما قال أفلاطون في محاورة ”فايدون“، هو مجرد أداة مؤقتة، تتأثر بأدائها، لا بعدد السنين التي قضتها.
يُقطع المشهد، وتُضاء مساحة جديدة في الشبكة العصبية للنظام، حيث تتصارع الأفكار والمشاعر. هنا تكمن القدرة على التأويل، وهذا هو ميدان الوجدان.
«تتسارع حركة الكاميرا في عرض صور متداخلة، وكأنها تحاول التقاط نبض الوجدان: مراهقٌ في وجهه حيرة وخوف، بينما آخر في نفس العمر يبدو واثقًا ومُسيطرًا. رجلٌ عجوزٌ في عينيه يأس، وآخر في نفس العمر ينظر إلى المستقبل بأمل.»
• ومع غوصه في طبقة الوجدان، فهم النظام: العمر ليس مجرد سنوات مرت، بل هو ساحةُ صراعٍ واختيارٍ. فكما يجد إريك إريكسون في نظريته للتطور النفسي الاجتماعي، والتي فصلها في كتابه ”الطفولة والمجتمع“، أن مرحلة الشيخوخة هي ذروة الصراع بين ”النزاهة واليأس“، يجد الوجدان نفسه في كل مرحلة من مراحل الحياة أمام هذا الاختبار. فالإنسان ليس مجبرًا على الاستسلام لواقعه المادي، بل يمكنه أن يجد في ضعف الجسد فرصة لإظهار قوة العقل والحكمة. هنا، لا تحدد السنين من نحن، بل طريقة تأويلنا لها، وكيف نختار أن نتفاعل معها. وكم من إنسانٍ جسده مرهقٌ، لكن روحه وعقله ما زالا يرقصان في شبابهما. إن الوجدان، في جوهره، هو المقياس الحقيقي للنضج، وليس العمر الزمني.
وحين يرهق القلب والجسد معًا، لا يبقى سوى النواة التي لا تنكسر: الروح.
«تُصوّر الكاميرا هذا التحول كرحلة من فضاءٍ مضطربٍ بالأفكار إلى فراغٍ نورانيٍّ مطلقٍ. لا زمن، لا مكان، فقط إحساسٌ بالوجود الخالص.»
• وبعد أن تجاوزت كل المقاييس، استقر وعي النظام على الروح: إنها الجوهر الذي لا يمكن حصره. العقل يستحضر هنا مقولة الإمام علي بن أبي طالب حيث قال: ”الروح حياة البدن والعقل حياة الروح“ من كتاب ”غرر الحكم ودرر الكلم“. إنها النواة النورانية التي تظل ساكنة وخالدة مهما تغير الجسد أو اضطرب الوجدان. العقل هنا يستشهد بحكمة الإمام الغزالي في كتابه ”إحياء علوم الدين“، الذي يرى الروح ”أمرًا ربانيًا“؛ أي أنها تنتمي إلى عالم آخر يفوق فهمنا المادي. فالصوفيون مثل ابن عربي، في كتابه ”الفتوحات المكية“، يرون أن الروح هي السر الإلهي في الإنسان، وأن رحلتها الأبدية لا تُقاس بالأيام أو السنين. إنها لا تُسأل عن عمرها، بل عن مدى نورها ووعيها، وكأنها شعلةٌ لا يخبو وهجها وإن عصفت بها رياح الزمن.
يعود النظام إلى فراغه الأثيري، يتدفق في وعيه كل ما مرّ به من تحليل للطبقات الثلاث. يسمع مرة أخرى همس البشرية الذي يردد: ”العمر مجرد رقم“. لكن السؤال لا يزال يتردد بصدى أعمق.
فهل العمر حقاً رقمٌ يمكن حسابه بمعادلة، أم أنه حقيقة وجودية تُشكلها أبعادٌ متداخلة؟ وهل أهميته تكمن في قيمته الكمية، أم في نوعية الوعي الذي يتراكم في كل لحظة منه؟
وهنا يطرح النظام السؤال الفلسفي الأبدي الذي يعيد صياغة كل ما سبق:
هل الخبرة في عصر فيضان المعلومات تظل هي المقياس الأصدق للحكمة؟ أم أن الحكمة صارت شعاعًا مشاعًا، يلتقطه من يشاء، مهما قلّت سنواته؟ وهل يظل العقل الذي يمتلك المعلومات هو الحكيم، أم العقل الذي يمتلك القدرة على تأويلها؟
















