المنفى الأنيق: حين تضل الذات طريقها إلى الاكتمال
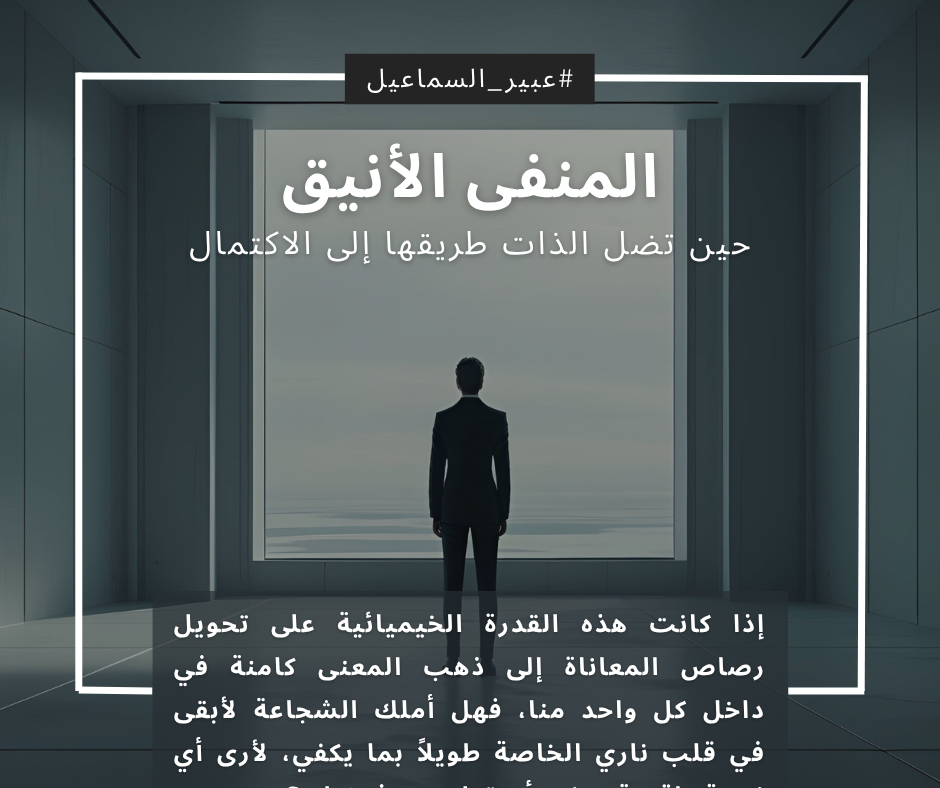
كان المشهد بسيطاً في تفاصيله، زلزالاً في أثره. فنجان قهوة، وزميل يميل بجسده كله إلى الأمام، لا برأسه فحسب، وعيناه تلمعان بتلك الحماسة النقية التي تسبق كشفاً عظيماً. كان يصف كيفية عناق الأفكار لأرواحنا، لا كرسائل بريدية تصل مختومةً إلى وجهتها، بل كبذورٍ تُلقى في تربة غريبة، فتتحد مع عناصرها لتُنبت شيئاً لم يكن في حسبان الزارع أو الأرض. ثم قال جملته التي أشعلت الفتيل: ”الأمر أشبه بمن يحكُّ دماغي... a brain scratch“
ابتسمتُ. فالعبارة لامست بدقة تلك اللذة الفكرية الخفيفة. لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن مجرد حكةٍ عابرة. شاركني الزميل مقالاً لرجل الأعمال خالد الحميضان، مقالٌ يدور حول مفهوم نفسي لم أكن قد غصتُ في أعماقه من قبل.
هنا، تحولت الحكّة اللطيفة إلى شيء آخر. شعرتُ بمخالب فكرية، حادة وباردة، لا تكتفي باللمس، بل تغوص عميقاً، تحفر في تلافيف الوجدان وتنبش عن طبقات منسية. لقد كان حفراً مؤلماً، لكنه ذلك الألم المعرفي اللذيذ الذي يسبق ولادة الوعي. ومن رحم هذا الحفر، وُلِد هذا المقال.
عندما صادفتُ مصطلح ”الوظيفة المتعالية“ «Transcendent Function» لأول مرة، أحسستُ بتلك الهزة المدهشة التي ترافق الأفكار الكبرى. كان فيه صدى يفسر شتاتاً كثيراً عالقاً في ذهني. وبشكل عفوي، حاولتُ أن أُسْقِطه على منظومتي لفهم الإنسان: الجسد «القالب المادي»، الوجدان «ساحة الصراع والاختيار»، والروح «النواة النورانية». لكنني شعرتُ بالضياع. بدا المصطلح قطعة إضافية في أحجية مكتملة، قطعة لا مكان لها. هل هو طبقة رابعة؟ أم أنه موازٍ للروح في كينونته؟
كدتُ أن أتخلى عن عدستي المنهجية، إلى أن أضاء الفهم ظلمة الحيرة: ”الوظيفة المتعالية“ ليست طبقة إضافية على الخارطة، بل هي المحرك الذي يُمكّننا من الحركة بين الطبقات. إنها ليست جزءاً من تضاريس الذات، بل هي المركبة التي نستخدمها للسفر عبر هذه التضاريس. من هذا الإدراك، بدأت رحلة الفهم الحقيقية.
وقبل أن نشرّح هذا المصطلح بمعناه العلمي، دعوني أطلب منكم سعةً في البال والصدر. اسمحوا لي أن أنظر إليه أولاً من زاويتي الخاصة، كإنسانة تختبر الحياة، لا كباحثةٍ تحلل المصطلحات. ففي هذه الزاوية الشخصية، يكمن البعد النفسي الأعمق والأكثر صدقاً.
وهنا، لا بد من التوقف عند محطة مؤلمة لكنها ضرورية: محطة ”الحلول الزائفة“. تلك الوصفات النفسية السريعة التي تُغلّف كحكمة وتُقدّم كدواء. شعارات براقة يطلقها، بحسن نية غالباً، غير المتخصصين، فتُلقى على من يصارع في الأعماق. لكن الفاتورة النفسية الباهظة يدفعها وحده من يعاني في صمت، حين يكتشف أن هذا ”الدواء“ المزعوم قد زاد من مرضه، أو في أحسن الأحوال، جعله يدور في حلقة مفرغة من الوهم.
لماذا هذه المحطة؟ لأن اكتشاف مفهوم عميق ك ”الوظيفة المتعالية“ يكشف لنا في المقابل ضحالة وسطحية تلك الحلول. وهنا نسأل: ماذا لو كانت بعض هذه الحلول الشائعة هي جزء أساسي من المشكلة؟
من هذا التساؤل تبدأ رحلتنا: ليس في شرح المفهوم أولاً، بل في تفكيك الحلول الزائفة التي يأتي هو كبديل حقيقي وجذري لها.
المشهد الأول: لقطة سينمائية، لا تحتاج إلى حوار. رجل يجلس على مكتبه في ضوء النهار الباهت الذي يتسلل من النافذة. الأوراق أمامه في نظام مثالي، وشاشة الحاسوب تضيء قناعاً من الفراغ على وجهه. هو لا يشعر بحزنٍ يمكن أن يشير إليه بإصبعه ويقول ”أنا حزين“. ما يشعر به أعمق وأكثر إرباكاً: فوهة. فجوة باردة في منتصف صدره تسحب كل الألوان والأصوات إلى داخلها، تاركةً خلفها صمتاً رمادياً ثقيلاً.
تمتد يده ببطء، كحركة غريق يبحث عن قشة، نحو هاتفه. إنه طوق النجاة في هذا المحيط من الصمت. يتوقف إبهامه فوق زر الاتصال، معلقاً بين الرغبة والحكمة الزائفة. يتردد في رأسه ذلك الصوت الواثق، المصقول كإعلان تجاري ”اكتفِ بنفسك. قوتك في استقلالك. لا تكن محتاجاً.“
يسحب يده ببطء، كمن يُلغي أمراً مصيرياً. يعيد الهاتف إلى مكانه على الطاولة. الآن، لم تتسع الفوهة في صدره فحسب، بل زاد ألمها. لقد أحاط بها جدار جديد، جدار من العزلة الباردة والشعور المرير بالفشل، لأنه فشل حتى في طلب النجاة.
هذا المشهد الصامت ليس مجرد لقطة عابرة، بل هو فيلم قصير يُعرض كل يوم في حيوات كثيرة، ومنه تنطلق الوصفة العصرية الجاهزة: ”عليك أن تكتفي بنفسك“. ولكن، هل هذا هو الحل حقاً، أم أنه مجرد تعميق للجرح تحت ستار القوة؟
هنا، لا بد أن نعود إلى تصميمنا الفطري. فمن حكمة أرسطو في كتابه ”السياسة“ بأن الإنسان ”حيوان اجتماعي“، إلى رؤية ابن خلدون في ”مقدمته“ بأن العمران البشري لا يقوم إلا على ”الاجتماع“، أجمع حكماء البشر على أننا كائنات لا تكتمل إلا بالآخر. ويأتي علم النفس الحديث مع أبراهام ماسلو في نظريته عن ”هرم الحاجات“، وجون بولبي في ”نظرية التعلق“، ليؤكدا أن حاجتنا الأصيلة للحب والانتماء والارتباط الآمن هي أساس صحتنا النفسية. بل إن النص الإلهي نفسه يؤسس لهذه الحاجة في جوهر الخلق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [سورة الحجرات، الآية 13].
قد يعترض معترض، وبحق: ”لكن الاكتفاء الذاتي لا يعني العزلة، بل القوة النفسية!“. وهذا صحيح في عالمه النظري النقي، لكنه يخفي في طياته منزلقاً خطيراً حين يتحول إلى شعار يُطبق على أرض الواقع المعقدة. فبسبب الخوف من ألم الهجر أو الخذلان، يتحول الهدف النبيل من ”أن أكون قوياً في علاقاتي“ إلى هدف دفاعي هو ”أن أكون قوياً من العلاقات“. وبذلك، نبني حول أنفسنا قلعة منيعة من العزلة، ونزين أسوارها بلافتة أنيقة كتبنا عليها: ”اكتفاء ذاتي“.
وهنا، يجب أن نتوقف ونسأل بصدق: ألا يؤدي هذا الطريق إلى نوعٍ من أنواع الانعزال غير الصحي؟
من هذا التساؤل، ينسحب الضجيج الخارجي، ليقف بنا في سكون تام أمام مرآة الروح، ويهمس في أذن كل واحد منا: هل هذا ”الاكتفاء“ الذي نتباهى به، هو حقاً حالة أصيلة من الامتلاء، أم أنه مجرد ظلٍ باهتٍ لمعنى أعمق أضعناه في الطريق؟ هل هذه الذات التي أراها أمامي، هي حقًا وطنٌ للروح ومستقرٌ لها، أم أنها مجرد منفى أنيق... تعلمتُ أن أسميه بيتاً؟
نترك الآن سجن الاكتفاء الخارجي، لنغوص في منفى أشد عمقاً ووحشة: منفى الروح حين تواجه ذاتها. في تلك اللحظات التي تخبو فيها الألوان ويثقل فيها الوجود، حين يطرق الخوف أبواب الصدر أو يخيّم الكدر على الأيام، يظهر نوع آخر من الحلول الجاهزة، حلٌّ يرتدي هذه المرة عباءة القداسة.
المشهد الثاني: لقطة واسعة لغرفة يغمرها سكون ثقيل، لا يقطعه سوى الأزيز الخافت لمكيف الهواء. على السرير، تستلقي هي. لا تتحرك، لكن عينيها مفتوحتان، تحدقان في السقف دون أن تريا شيئاً. أنفاسها قصيرة، كأن مجرد الشهيق والزفير يتطلب مجهوداً جباراً. ثم، ليس كانتفاضة كابوس، بل بحركة بطيئة ومرهقة كمن يرفع جبلاً، تجلس وتضم ركبتيها إلى صدرها. إنها حركة غريزية، ليس للاحتماء من عدو خارجي، بل في محاولة يائسة لترويض وحش من الكدر والهلع يجثم على صدرها.
في هذا الصقيع النفسي، يتردد صوت بارد، لا كهمس مواساة، بل كاستجواب محقق: ”أنتِ بعيدة عن ربك... هل قرأتِ وردكِ اليوم؟ هل تحصنتِ؟ هذا كله من الذنوب والبعد عن الدين.“
ولكن في مقابل هذا المنطق الاتهامي، ترسم خرائط الحكمة الحقيقية مساراً مختلفاً تماماً. نجد هذا المسار في سيرة الإمام أبي حامد الغزالي، ونجده كبرهان عملي مع الطبيب النفسي فيكتور فرانكل. هذا الفهم متجذر في حكمة الإمام علي  في ”نهج البلاغة“، حين يقرّ بأن للقلوب ”إقبالاً وإدباراً“. ولعل السابقة الأسمى تتجلى في قصة النبي إبراهيم
في ”نهج البلاغة“، حين يقرّ بأن للقلوب ”إقبالاً وإدباراً“. ولعل السابقة الأسمى تتجلى في قصة النبي إبراهيم  حين قال: ﴿بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260].
حين قال: ﴿بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260].
من هذه الأمثلة نرى أن السعي ليقين القلب ليس ضعفاً في الإيمان، بل هو أرقى درجات الإيمان نفسه.
وهنا، يقف كل واحد منا وحيداً في عمق بئره الخاصة، ويسأل نفسه بصمت: هل أملك حقاً المعرفة والبصيرة لأكون طبيب نفسي وجرّاحها في آنٍ واحد؟ هل لديّ الحكمة لأقرأ شيفرة هذا الألم؟ والسؤال الأكثر عُرياً: حتى لو عرفت الجواب، فهل بقيت في روحي ذرة من قوة، لأعترف بأنني لا أقدر، وأخطو تلك الخطوة الأكثر صعوبة... خطوة طلب المساعدة؟
وهكذا، نكون قد مررنا على نموذجين فقط من بحر الحلول الزائفة التي تُطرح في ساحتنا اليوم. وهما ليسا إلا عينة بسيطة، ترينا كيف يمكن لأكثر الحلول شيوعاً أن تكون هي ذاتها جزءاً من المشكلة.
قد يسأل القارئ الآن، بعد كل هذا الغوص وتفكيك هذه العينات من الحلول الزائفة: ما هو البديل إذن؟ وما علاقة كل هذا بموضوعنا الأساسي، ”الوظيفة المتعالية“؟
والجواب يكمن في أننا لم نكن ندور في حلقة مفرغة، بل كنا نرسم حدود الحلبة التي لا يظهر فيها هذا البطل إلا حين تشتد المعركة. فالوظيفة المتعالية، كما طرحها الطبيب النفسي كارل يونغ في أعماله مثل ”بنية النفس“، ليست رفاهية فكرية، بل هي معجزة لا تولد إلا من رحم المعاناة. هذه الفكرة ليست حكراً عليه، بل هي صدى لمفهوم ”التركيب“ «Synthesis» في جدلية هيغل في كتابه ”فينومينولوجيا الروح“، وهي ”النجمة الراقصة“ التي قال الفيلسوف فريدريك نيتشه في كتابه ”هكذا تكلم زرادشت“ إنها لا تولد إلا من رحم الفوضى الداخلية.
إنها قدرة النفس الفطرية على خلق مخرج جديد حين تكون عالقة بين قوتين متضادتين. حين يحتمل الوجدان هذا التوتر المؤلم إلى أقصاه، ينبثق ”شيء ثالث“ من اللاوعي. ليس حلاً وسطاً رمادياً، بل هو منظور جديد تماماً. إنها باختصار، قدرة النفس على خلق المعنى من قلب العبث.
وهنا نصل إلى السؤال الأخير، السؤال الذي لا يطرحه المقال، بل يتركه أمانة في وجدان كل قارئ:
إذا كانت هذه القدرة الخيميائية على تحويل رصاص المعاناة إلى ذهب المعنى كامنة في داخل كل واحد منا، فهل أملك الشجاعة لأبقى في قلب ناري الخاصة طويلاً بما يكفي، لأرى أي نجمة راقصة يمكن أن تولد من فوضاي؟
وهنا نصل إلى السؤال الأخير، السؤال الذي لا يطرحه المقال، بل يتركه أمانة في وجدان كل قارئ:
إذا كانت هذه القدرة الخيميائية على تحويل رصاص المعاناة إلى ذهب المعنى كامنة في داخل كل واحد منا، فهل أملك الشجاعة لأبقى في قلب ناري الخاصة طويلاً بما يكفي، لأرى أي نجمة راقصة يمكن أن تولد من فوضاي؟
وهل يكون الوطن الحقيقي للروح، في نهاية هذا الدرب، ليس مكاناً نصل إليه، بل هو تلك القدرة الخيميائية ذاتها؛ قدرتنا على تحويل أي منفى، مهما كان بارداً وموحشاً، إلى مساحةٍ دافئة للمعنى؟
















