أنا النهر، لا التمثال
عن الهوية التي ترفض أن تُقرأ، وتختار أن تظل صيرورةً في الضباب.
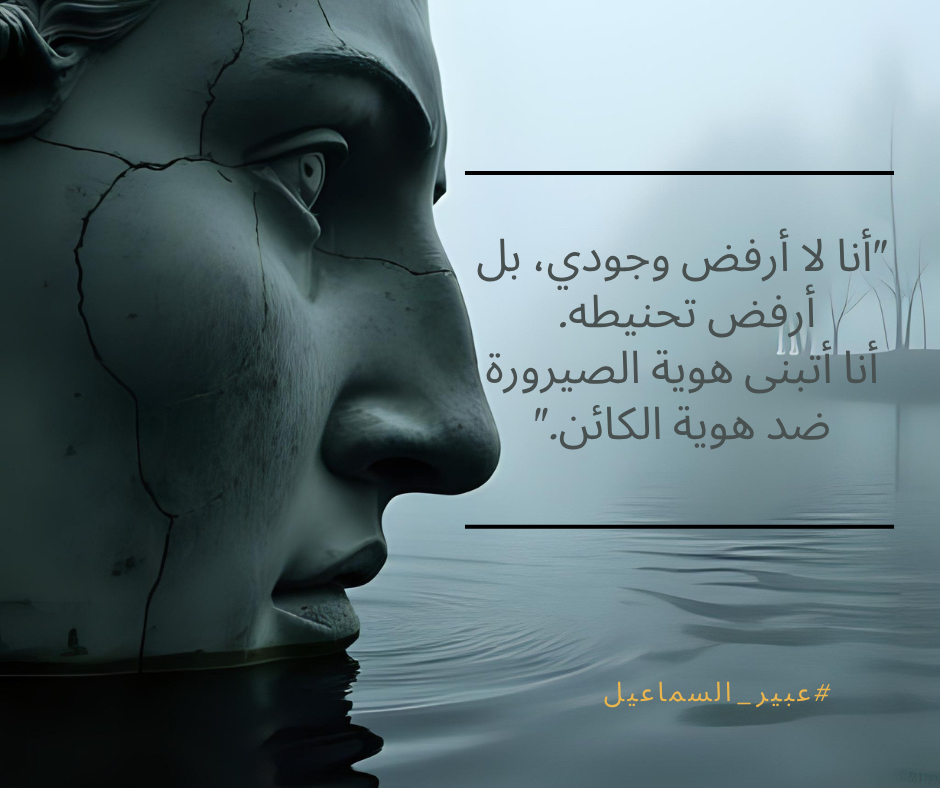
قبل أن نبدأ رحلتنا في هذا المقال، أود أن أتوقف عند نقطة البداية الحقيقية له. لم يولد هذا النص من فراغ، بل كان استجابةً لسؤال عميق، بذرة فكرية زُرعت في تعليق من الأستاذ نواف عيسى على مقال سابق بعنوان: ”قشرة النواة… حين يُختبر العمق من أول نظرة“ - جهات الإخبارية. يومها، كتب الأستاذ نواف قائلًا:
”فيه جانب لم يطرحه المقال يوضّح: ماذا عن أولئك الذين يرفضون ’البراند’ سواء كان شخصيا أو تجاريا؟ أليس فيهم صدق آخر؟ أتمنى نسمع منك مقال ثاني عن ’اللاهوية’ أو ’التمرد على الصورة’؟“
في تلك اللحظة، شعرتُ أن هذا السؤال أكبر من أن يُجاب عليه في ردٍ عابر. إنه سؤال يستحق مقالًا بأكمله، بل يستحق رحلة من البحث والتفكير قبل الإمساك بالقلم. لم أرغب في الرد قبل أن أكون جاهزة، ليس فقط بفكرة، بل بعلمٍ وفلسفة تؤسس لجواب يليق بعمق السؤال.
وها هو ذاك السؤال، لم يعد مجرد همسة في خانة التعليقات، بل صار صدىً يتجسد أمامكم.
في سوقٍ عالميّ، حيث النظرات هي العُملة، وحيث كل إنسانٍ معروضٌ في واجهة زجاجية لامعة، يظهر متمردون يرتدون معاطف الضباب. هم فئةٌ نادرة لا تريد أن تُختزل في سيرة ذاتية، ولا أن تُحبَس في شعار، ولا حتى أن تُحكى في كلمات تُكتب عنهم. يختارون الغموض، لا عن جهلٍ، بل كفعل مقاومة. يرفضون أن يكونوا ”مقروئين“، أن يكونوا ”واضحين“ وضوح السلعة على الرف.
لكن، ما هي هذه الهوية أصلًا؟ وهل هي قدرٌ نرتديه، أم أنها مجرد ثوبٍ يملك الإنسان ترفَ تمزيقه؟
الهوية هي تلك المفارقة... هي الشيء الذي يجعلك أنت، وفي اللحظة ذاتها، الشيء الذي يضعك في صندوق ليسهل على الآخرين فهمك. في مختبر علم النفس، هي ”الإحساس المتماسك بالذات“. وفي قاعات التسويق، هي ”السمات التي تمنح المنتج قيمة سوقية“.
أما في مسرح الحياة، فالهوية هي ”الطريقة التي نُعرّف بها أنفسنا لأنفسنا، ثم نفاوض بها العالم“. هي جلدنا الثاني الذي نخيطه من خيوط الألوان والكلمات والإيماءات. وإذا أردنا أن نُسقط لغة السوق القاسية على الإنسان، لقلنا إن الهوية هي:
• الاسم التجاري: اسمك الذي يُنادى به في ساحة العالم، والصفات التي تُلحق به كظله.
• العلامة البصرية: أسلوبك الذي يمشي معك. نبرة صوتك. طريقة تحريك يديك. هي الخطوط والألوان التي ترسم بها حدودك المرئية.
• القيمة السوقية: وزنك في بورصة العلاقات الإنسانية. هي منظومتك الأخلاقية والدينية، رأس مالك الرمزي الذي يمنحك الثقة والاحترام أو يجرّدك منهما.
• الرسالة: الصدى الذي تتركه خلفك حين تغادر الغرفة. لماذا وُجدت؟ وما أثرك في هذا الوجود؟
لكن هنا، في قلب هذه المقارنة، يكمن الصدع العميق: المنتج يُصنع ليُباع، ليُستهلك، ليُقرأ في لمحة. والإنسان، كلما تعمقت في قراءته، ازداد غموضًا وجمالًا.
هنا، لا يعود السؤال مجرد تأملٍ فلسفي، بل يصبح صرخة وجودية. هل ”الهوية“ بطاقة نختارها بحرية من بين رفوف متجرٍ أنيق، أم هي وشْمٌ حُفِر على أرواحنا بالحبر الساخن منذ الولادة؟ الرافض للهوية ”المقروءة“ لا يرفض فقط كيف يراه الناس، بل يثور على كل ما يشعر أنه قيدٌ فُرض عليه: اسمه، ماضيه، لهجته، جسده. إنه يرفض أن يكون كتابًا مفتوحًا بحبكة متوقعة.
وهنا، تتقاطع دروبنا مع مقالنا الأول عن الإنسان قبل أن تلوثه التعريفات: عن ”جلدية الظل والجوهر“. فالرافض لا يرفض جلده الأول، جلد الجوهر الفطري، بل يرفض الجلد الثاني، الجلد المكتسب الذي خاطه له العالم أو الذي خَاطه هو بنفسه ليرضي العالم. إنه يثور على الهوية ”المقروءة“ «البراند»، ليعود إلى هوية الظل: تلك المنطقة العميقة، الغامضة، في كينونته التي لا تصل إليها أضواء التقييمات ولا ضجيج التصنيفات.
محاولته ليست خلع الجلد، بل السماح للجلد الحقيقي بالتنفس تحت طبقات الطلاء الاجتماعي. إنه يقاتل ليقول: ”أنا لستُ ما ترون على السطح، أنا كل ما لا تستطيعون رؤيته. أنا لستُ هوية تُقرأ، أنا جوهرٌ يُستشعر“.
”رافض الهوية“ ليس كائنًا بلا ملامح، ولا هو شخصٌ تائهٌ في العدم. بل على العكس، هو حارسٌ أمين على تعقيداته، فنانٌ يرفض أن يضع توقيعًا نهائيًا على لوحته المتغيرة باستمرار. لفهم هذا الموقف، دعنا نُشعل مصباحين: مصباح علم النفس ومصباح الفلسفة.
أولًا: نظرة علم النفس - من ”أزمة الهوية“ إلى ”الهوية السائلة“ عادةً ما يُنظر إلى الحيرة في تعريف الذات على أنها ”أزمة هوية“ «Identity Crisis»، وهو المفهوم الذي صاغه وطوره عالم النفس إريك إريكسون في كتابه ”الطفولة والمجتمع“ «Childhood and Society, 1950»، حيث اعتبرها مرحلة مربكة يجب تجاوزها للوصول إلى هوية مستقرة. لكن ”رافض الهوية“ يقلب هذه المعادلة، فلا يراها ”أزمة“ تحتاج إلى حل، بل ”مساحة استكشاف“ يختار أن يعيش فيها. هنا، يظهر مفهوم أكثر حداثة وهو ”الذات البروتينية“ «Protean Self»، وهو مصطلح صاغه الطبيب النفسي روبرت جاي ليفتون في كتابه ”الذات البروتينية: المرونة البشرية في عصر التجزئة“ «The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation, 1993». نسبةً إلى ”بروتيوس“، إله البحر الإغريقي الذي كان يغيّر شكله باستمرار، فالرافض، من منظور نفسي، ليس شخصًا فاشلًا في بناء هويته، بل هو شخص يتبنى بوعيٍ السيولة كآلية للبقاء أصيلًا.
ثانيًا: نظرة الفلسفة - من ”الوجود“ إلى ”مقاومة السلطة“ تجد فكرة رفض الهوية صداها الأعمق في الفلسفة الوجودية. يصرخ جان بول سارتر بمقولته الشهيرة: ”الوجود يسبق الماهية“، وهي الفكرة المحورية في محاضرته وكتابه ”الوجودية مذهب إنساني“ «Existentialism Is a Humanism, 1946». هذا يعني أن الإنسان يُولد أولًا، ثم من خلال اختياراته، يصنع ماهيته. شعار ”رافض الهوية“ هو شعار وجودي بامتياز: ”أنا لستُ ما أنا عليه، أنا ما أختاره أن أكون في كل لحظة“. ومن زاوية أخرى، يرى ميشيل فوكو أن ”الهوية“ غالبًا ما تكون أداة للسلطة. فالمجتمع، كما يوضح في أعماله مثل ”المراقبة والمعاقبة“ «Discipline and Punish, 1975»، يخلق ”هُويات“ وتصنيفات ليسهل عليه السيطرة على الأفراد. ”رافض الهوية“ هنا هو متمرد على سلطة التعريف هذه، ويمارس ”مقاومة“ عبر التملص من هذه القوالب.
من سياق كل ما ذكر، تتضح أسباب هذا التمرد النبيل، ويمكن تلخيصها في أربعة أسباب جوهرية:
ا. التحرر من سجن الماهية «الدافع الوجودي»: السعي نحو الحرية المطلقة. يرفض أن يكون شخصية في رواية قد كُتبت نهايتها، ويسعى لأن يكون المؤلف الذي يمسك القلم حتى النفس الأخير.
ب. مقاومة سلطة التصنيف «الدافع السياسي الخفي»: يرفض أن يكون ملفًا سهل القراءة في أرشيف المجتمع. غموضه هو درعه، وعدم وضوحه هو بيانه السياسي الصامت.
ت. احتضان شرف التعقيد الإنساني «الدافع النفسي»: يرفض تسطيح محيطه الداخلي ليناسب خريطة العالم الخارجي. هو يجد شرفًا في كونه سعيدًا وحزينًا، قويًا وضعيفًا، مؤمنًا ومتشككًا.
ث. البحث عن الصدق الجذري «الدافع الأخلاقي»: كل هذه الأسباب تصب في البحث عن شكل جذري من الصدق. إنه أشبه بخلع قناعٍ أنيق لكنه خانق، من أجل أن يتنفس أخيرًا هواء الحقيقة النقي.
هنا، لا بد من وقفة شجاعة أمام سؤال منطقي: إذا كان كل فعلٍ هوية، فكيف يمكن ”رفض الهوية“؟ أليس ”الرفض“ نفسه هوية جديدة؟ الحل يكمن في التمييز الجذري بين هوية ”الكائن“ «Identity as Being» وهي الهوية كشيء ثابت ومكتمل، وهوية ”الصيرورة“ «Identity as Becoming» وهي الهوية كعملية مستمرة. هذا التمييز قديم قدم الفلسفة، فالفيلسوف اليوناني هرقليطس أشار إليه حين قال مقولته الخالدة: ”لا يمكنك أن تنزل في النهر مرتين“ «كما ورد في محاورات أفلاطون، وتحديدًا محاورة ”كراتيلوس“». وفي العصر الحديث، تجسدت هذه الفكرة بقوة في فلسفة فريدريك نيتشه عن ”تجاوز الذات“ «Self-overcoming»، وهي فكرة محورية في كتابه ”هكذا تكلم زرادشت“ «Thus Spoke Zarathustra, 1883». الإنسان الأرقى ليس من ”يجد“ هويته، بل من ”يخلقها“ ويتجاوزها باستمرار.
إذًا، ”رافض الهوية“ لا يناقض نفسه. هو لا يرفض وجوده، بل يرفض تحنيطه. يتبنى بوعيٍ هوية الصيرورة ضد هوية الكائن. يرفض أن يكون تمثالًا، ليظل نهرًا.
في بداية رحلتنا، شبهنا الهوية بالمنتج ذي العلامة الواضحة. والآن، في نهايتها، نكتشف الحقيقة المزعجة: أننا لسنا مجرد مصممين لهوياتنا، بل نحن أيضًا مستهلكون شرهون لهويات الآخرين. حين يعجبنا منتج ما، فإننا نأمل ألا يتغير أبدًا. وها هي الكارثة: نحن نفعل الشيء ذاته مع البشر.
حين نلتقي بشخص يوافق ”نسخة“ معينة في أذهاننا، نحبه، ونلصق عليه هوية ثابتة كعلامة تجارية. ”رافض الهوية“ هو ذلك المنتج الذي أعلن التمرد على خط الإنتاج، ورفض أن يكون تجربتنا المألوفة والمريحة. تمرده يزعجنا ليس لأنه سيئ، بل لأنه يكشف حقيقة استهلاكية فينا: أنه يذكرنا بأننا نتعامل مع ”صيرورة“ حية، لا مع ”كائن“ جامد. استجوابنا له ليس فضولًا بريئًا، بل هو أقرب إلى شكوى مستهلك غاضب يصرخ: ”لقد غيرتم المنتج الذي أحببته!“.
وهنا، يجب أن يتغير السؤال الذي يطرح نفسه علينا، ليصبح أكثر صدقًا ووجعًا. السؤال الحقيقي ليس: ”لماذا يرفض هؤلاء هوياتهم؟“. بل: ”لماذا نغضب نحن، حين يرفض الإنسان أن يكون سلعتنا؟“
















