فلسفة الهوية: من جوهر ”الأمر“ إلى أثر ”الاختيار“
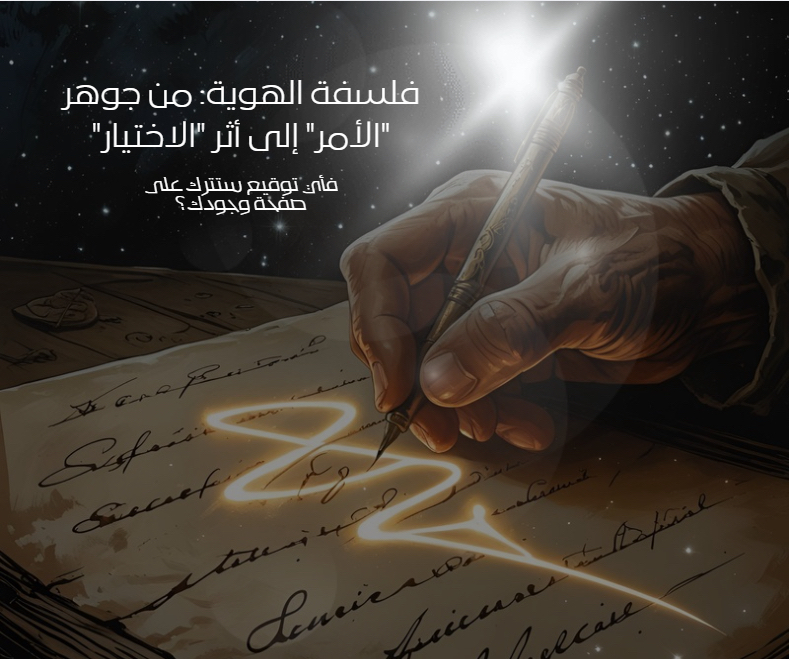
في عالمٍ يطالبنا باستمرار أن نكون نسخة أفضل، هل توقفنا لنسأل: نسخة أفضل من ماذا؟ وعلى أي أساس؟ هذا المقال رحلة فلسفية عميقة في جدلية ”المنتج“ الأصلي الذي نحن عليه، و”الهوية“ التي نقدمها للعالم، بحثًا عن استراتيجية للوفاء للجوهر لا الانصياع للسوق.
في لحظةٍ لا يقيسها زمن البشر، انبثق ”أمرٌ“.
ليس صوتًا تدركه الآذان، ولا ضوءًا تلتقطه الأبصار، بل هو حدثٌ وجوديٌ، إيذانًا ببدء فصلٍ جديد من حكاية الخلق. إرادةٌ متعاليةٌ ستهب لهذا الكون خليفتها ووارثها. هي اللحظة التي يلخصها الوحي في آيةٍ واحدة هي مفتاح كل خلق:
﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [سورة يس، الآية 82].
من رحم هذا ”الأمر“ الإلهي، وُلد ”المنتج“ الأول الذي يهمنا في رحلتنا هذه: الإنسان. لم يكن منتجًا بسيطًا، بل تحفة فنية منسوجة من نقيضين: قبضة من ”طين“ تمثل القالب، وفي جوفها، أثرٌ من ذلك ”الأمر“ الخالق، نفخةٌ من روحٍ هي سر قيمته وجوهره.
وهنا، تبدأ حكايتنا نحن. فمع هذا المنتج الفريد، تُرِكت لنا المساحة لنخطّ عليه ”الهوية“، الهوية هي العلامة «البراند» التي نصنعها لأنفسنا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلحات مثل ”المنتج“ و”البراند“ و”نظام التشغيل“ التي سنستخدمها، هي استعارات فلسفية لتقريب المعنى، لا مصطلحات علمية جامدة. فالهوية قد تكون توقيعًا أمينًا يعكس عظمة الصانع، أو قد تكون قناعًا متقنًا يخفي حقيقة الأصل.
هذا المقال ليس بحثًا عن إجابات نهائية، بل هو محاولة جادة لصياغة استراتيجية فلسفية للتعامل مع هذا التحدي الوجودي. سنبحر معًا في جدلية ”المنتج“ الذي صُنعنا عليه، و”الهوية“ التي نصنعها نحن، لا لنسأل ”هل نحن أوفياء للأصل؟“ فحسب، بل لنسأل ”كيف“ يمكننا بناء منهجية واعية نكون بها كذلك.
لكي نبني استراتيجية واعية لإدارة ”الهوية“، علينا أولاً أن نفهم بعمق طبيعة ”المنتج“ الذي بين أيدينا. هذا المنتج، وهو الكيان الإنساني، ليس بناءً بسيطًا، بل هو عالمٌ مركب من طبقات متداخلة.
وهذا التقسيم الثلاثي للكيان الإنساني ليس جديدًا، بل هو حجر الزاوية في فهم النفس عند كبار مفكري الإسلام. نجد هذا التفصيل جليًا عند حجة الإسلام الإمام الغزالي في ”إحياء علوم الدين“، وعند ابن سينا في ”كتاب النفس“، وعند ابن القيم الجوزية في ”الروح“. بناءً على هذا الإرث الفكري العميق، يمكننا تشريح الإنسان إلى ثلاث طبقات رئيسية:
الطبقة الأولى: الجسد «القالب المادي» هذا هو وعاء الطين، مركبتنا الأرضية التي نخوض بها رحلة الحياة.
الطبقة الثانية: الوجدان «ساحة الصراع والاختيار» هنا تكمن حقيقة تعقيدنا البشري. الوجدان هو ال ”Psyche“ بلغة علم النفس، وهو الساحة التي تدور فيها معركة الاختيار بين قوى العقل والقلب والنفس «الأنا/Ego». هذا ”الوجدان“ هو ما يخضع لعملية البرمجة والتأثر.
الطبقة الثالثة: الروح «النواة النورانية» في أعمق نقطة من هذا الكيان، تكمن ”الروح“. هي ليست جزءًا من الصراع، بل هي النور الذي يكشف حقيقته. هي ”الفطرة“ التي لا تتلوث، والبوصلة التي لا تخطئ. الروح لا تحتاج إلى إصلاح، بل تحتاج إلى ”كشف“.
وهذه النظرة المركبة للطبيعة الإنسانية ليست حكرًا على تراثنا. ففي الفلسفة اليونانية، نجد أفلاطون في كتابه ”الجمهورية“ يقسم النفس إلى ثلاثة أجزاء «عاقلة وغضبية وشهوانية». وفي العصر الحديث، نجد الطبيب النفسي النمساوي فيكتور فرانكل في كتابه ”الإنسان يبحث عن المعنى“، يؤكد على وجود بُعد إنساني ثالث فريد، أسماه البعد ”الروحي“. كما أن الطبيب النفسي السويسري كارل يونغ في ”نماذج اللاوعي الجمعي“ تحدث عن ”الذات“ «The Self» كمركز أصيل وعميق في الإنسان.
إذًا، فالصراع الذي نعيشه هو صراع داخل ”الوجدان“ نفسه. ومن هنا، تصبح عملية ”التخلية والتحلية“ هي عملية ”تهذيب للوجدان“ ليعمل بانسجام مع نداء الروح. وهذا ما لخصه الدكتور تركي العجيان في كتابه ”كيمياء الذات“ حين شبّه هذا الوجدان بـ ”نظام تشغيل“ قابل لإعادة البرمجة والتنقية.
هنا ندخل عالم ”الهوية“ كفعل متحرك. وقبل أن نسأل عن التغيير، يجب أن نعترف بحقيقة أساسية: الطبيعة البشرية، بفطرتها، تطلب القبول والانتماء. هذه ليست علامة ضعف، بل هي نقطة انطلاقنا جميعًا. الصراع الحقيقي ليس في وجود هذه الحاجة، بل في كيفية تلبيتها.
فما يحدد وجهة هويتنا ليس مصدر التأثير «داخليًا كان أم خارجيًا»، بل وجود أو غياب العامل الأهم: الوعي بالذات. ولنوضح الفكرة، لنتناول التأثير من ميدانيه المختلفين:
أولاً: التعامل مع المؤثر الخارجي «القبول والانتماء»
لنتخيل شخصين كل واحد في غرفته، ضوء هاتفه هو النور الوحيد المنعكس على وجهه. إنه لا يقرأ أو يتواصل، بل يراقب. يقلب صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لا ليرى حياة الآخرين، بل ليدرس ”السوق“. ما الذي يجلب الإعجاب؟ أي نوع من الصور يحصد الثناء؟ ما هي الآراء الرائجة؟ أي مسار وظيفي يُحتفى به؟ إنه يقوم بـ ”دراسة جدوى“ لهويته القادمة.
• الشخص الأول، يعمل بتغيير غير واعٍ: لأنه يفتقر لوعي عميق بذاته، فإن ”دراسة السوق“ بالنسبة له هي بحث عن ”وصفة نجاح“ جاهزة ليقلدها. هو يرى نجاح الآخرين فيشعر بالفراغ، فيحاول أن يملأه بتقليدهم. لأنه لا يعرف كيف يوجه طاقاته، فإنه يضيع في دوامة الدارج، وتصبح هويته صدى لما هو مقبول في الخارج.
• الشخص الثاني، يعمل بتغيير واعٍ: لأنه يمتلك وعيًا بذاته، فإن ”دراسة السوق“ بالنسبة له هي فهم للخارطة ليعرف كيف يسير عليها بمركبته الخاصة. هو لا يسأل ”كيف أقلدهم؟“، بل يسأل: ”كيف أقدم حقيقتي الأصيلة لهذه الساحة بأفضل طريقة؟“. هو يستخدم المؤثر الخارجي كمعلومة استراتيجية، لا كقالب يصب نفسه فيه.
ثانيًا: التعامل مع المؤثر الداخلي «صراع النفس والعقل»
والآن، في الميدان الداخلي، لنتخيل شخصين آخرين، كلٌّ منهما في غرفته الهادئة. لا يوجد هاتف، لا توجد شاشات. يجلسان في سكون، ربما ينظران من النافذة إلى شجرة صامدة، أو يراقبان حركة أنفاسهما. إنهما لا يدرسان ”السوق“ الخارجي، بل يحاولان أن يصغيا لـ ”نظام تشغيلهما“ الداخلي. وفي لحظة وعي، يكتشف كلاهما أنه يعاني من نفس المشكلة الشائعة اليوم: ضعف التركيز وتشتت الانتباه. هذا إحساس داخلي بالنقص، فكيف يتعامل كل منهما مع هذا الاكتشاف؟
• الأول، يعمل بتغيير غير واعٍ «ردة الفعل والتخبط»: هذا الشخص يشعر بالانزعاج من تشتته، فيتعامل مع المشكلة كردة فعل عشوائية. في يوم يقرر حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي اليوم التالي يسمع عن تقنية جديدة فيطبقها لساعة ثم يتركها. هو يقفز من حلٍّ خارجي إلى آخر، لأنه يقاتل الأعراض لا المرض. هذا هو ”التخبط“، حركة كثيرة، لكنها لا تؤدي إلى أي مكان.
• الثاني، يعمل بتغيير واعٍ «الفعل الاستراتيجي»: هذا الشخص يبدأ من الداخل عبر الوعي بالذات. هو لا يسأل ”ما هي أحدث أداة للتركيز؟“، بل يسأل ”لماذا تركيزي ضعيف؟“. بناءً على هذه المعرفة، يتخذ قرارًا واعيًا ومحددًا، كأن يخصص نصف ساعة يوميًا للقراءة ك ”تمرين“ مقصود لتقوية ”عضلة التركيز“ لديه. هو لا يعالج المشكلة بشكل عشوائي، بل يبني الحل بشكل استراتيجي.
الخلاصة والحكم النهائي: نرى إذًا أن ما يغير النتيجة هو ”الوعي“. ولكن يجب أن ننتبه لنقطة أخيرة وحاسمة: الوعي والأصالة ليسا مرادفين للصلاح. فالوعي بالذات هو أداة محايدة وقوية. يمكن لشخص أن يستخدم وعيه العميق بطبيعته ليختار طريق الفضيلة والنمو، ويمكن لشخص آخر أن يستخدم نفس الوعي ليركز طاقاته على الشر والفساد بشكل أكثر فعالية.
إذًا، فالاستراتيجية التي نبحث عنها هي ذات شقين: أولاً، تنمية ”الوعي بالذات“ لنعرف حقيقتنا. وثانيًا، اتخاذ ”القرار الأخلاقي الواعي“ بتوجيه هذه الحقيقة نحو الخير. فالسؤال الجوهري ليس فقط ”هل كان تأثري واعيًا؟“، بل ”نحو أي غاية وجهتُ هذا الوعي؟“.
إن طريق الأصالة وعر، والسير فيه يستدعي نورًا نستدل به، وهذا النور هو ”القدوة“. ولكن، ما أن نذكر كلمة «قدوة»، حتى نميل تلقائيًا نحو أسماء معينة، ربما الرسول محمد ﷺ، والإمام الحسين  . وهنا، لا بد لنا من وقفة تأمل أعمق.
. وهنا، لا بد لنا من وقفة تأمل أعمق.
إن الإجابة على سؤال ”مَن نختار؟“ تكشف عن سر أعمق يتعلق بسؤال ”مَن نحن؟“. فاختيار القدوة هو فعل استبطاني، كشفٌ للذات من خلال ثلاث مرايا:
1. المرآة النفسية: اختيارنا كحاجة. نحن لا نختار قدوة لأننا كاملون، بل لأننا نشعر بالنقص. إعجابنا بشخصية معينة هو بوصلة نفسية تشير إلى الفضيلة التي يتوق وجداننا لتنميتها.
2. المرآة الفلسفية: اختيارنا كمبدأ. نحن لا نختار أشخاصًا، بل نختار ”نماذج أصلية“ «Archetypes» تجسد مبادئ خالدة، مثل:
• الإمام علي  : نموذج ”الحكمة التي تتحول إلى عدل“ على الأرض.
: نموذج ”الحكمة التي تتحول إلى عدل“ على الأرض.
• فاطمة الزهراء  : نموذج ”الحقيقة النورانية“ التي لا تحتاج لسلطة خارجية لتثبت وجودها.
: نموذج ”الحقيقة النورانية“ التي لا تحتاج لسلطة خارجية لتثبت وجودها.
• الإمام الحسين  : نموذج ”الوفاء للجوهر“ حين تطالبك الدنيا بتحريف المنتج.
: نموذج ”الوفاء للجوهر“ حين تطالبك الدنيا بتحريف المنتج.
• زينب  : نموذج ”صناعة الهوية من رحم الفاجعة“، وتحويل الألم إلى قوة ناطقة.
: نموذج ”صناعة الهوية من رحم الفاجعة“، وتحويل الألم إلى قوة ناطقة.
• العباس  : نموذج ”الوفاء“ كقيمة وجودية مطلقة.
: نموذج ”الوفاء“ كقيمة وجودية مطلقة.
3. المرآة الروحية: اختيارنا كشوق. كل قدوة هو مرآة تعكس ترددًا معينًا من النور الإلهي. وأرواحنا، في رحلتها الفريدة، تشتاق للتردد الذي تحتاجه لتنمو وتُشفى.
إذًا، فالغاية من القدوة ليست التقليد الأعمى الذي يلغي شخصياتنا، بل هي فعل وعي يساعدنا على فهم ذواتنا، لنستنير بنورهم ثم نمضي في طريقنا الخاص.
إذا كانت الشموس التي استنرنا بها في فصلنا السابق تضيء سماء تاريخنا الخاص، فإن الحقيقة كالنور، لا يمكن حصرها في سماء واحدة. إن الصراع بين الأصالة والزيف، والوفاء للجوهر في وجه ضغط الخارج، هو الدراما المركزية للكائن الواعي في كل مكان وزمان.
وهذا الصراع ليس مجرد اختبار فلسفي، بل هو في جوهره محنة الأنبياء وامتحان الصدّيقين. لنتأمل في قصة أبي الأنبياء إبراهيم  ، حين وُضع أمام أقسى اختيار: إما أن يتبنى ”هوية“ قومه ويعبد أصنامهم لينال القبول والأمان، أو أن يظل وفيًا لنداء التوحيد في روحه ويواجه النار. لقد اختار الوفاء لجوهر رسالته، فكانت النار عليه بردًا وسلامًا، ليس فقط بمعجزة مادية، بل بسلام الروح التي لم تخن حقيقتها.
، حين وُضع أمام أقسى اختيار: إما أن يتبنى ”هوية“ قومه ويعبد أصنامهم لينال القبول والأمان، أو أن يظل وفيًا لنداء التوحيد في روحه ويواجه النار. لقد اختار الوفاء لجوهر رسالته، فكانت النار عليه بردًا وسلامًا، ليس فقط بمعجزة مادية، بل بسلام الروح التي لم تخن حقيقتها.
ولننظر إلى السيدة مريم العذراء  ، وهي تواجه مجتمعها بآية إلهية لا يصدقها منطقهم. كان بإمكانها أن تبحث عن مخرج أو تبرير، لكنها اختارت أن تظل وفية لـ ”منتجها“ الإلهي، واثقة بأن الحقيقة التي تحملها أكبر من أي حكم خارجي، فصاغت هويتها من الصمت والتسليم.
، وهي تواجه مجتمعها بآية إلهية لا يصدقها منطقهم. كان بإمكانها أن تبحث عن مخرج أو تبرير، لكنها اختارت أن تظل وفية لـ ”منتجها“ الإلهي، واثقة بأن الحقيقة التي تحملها أكبر من أي حكم خارجي، فصاغت هويتها من الصمت والتسليم.
وحين نرى هذا المبدأ في أعلى صوره النبوية، يمكننا أن نرى أصداءه البشرية في كل قصة إنسانية كبرى. فالفيلسوف سقراط في أثينا اختار كأس السم على حياة زائفة. والمناضل نيلسون مانديلا اختار السجن لعقود على أن يحرف منتجه الداخلي القائم على الكرامة والحرية.
إن هذه الأمثلة، من قمة النبوة إلى عمق التجربة الإنسانية، تؤكد لنا أن رحلتنا ليست منعزلة. وأن كفاحنا اليومي من أجل الصدق هو جزء من كفاح البشرية الأبدي نحو المعنى.
بدأنا رحلتنا من ”الأمر“ الإلهي، والآن نهبط إلى أرض الواقع لنسأل: كيف نترجم هذه الاستراتيجية إلى حياة؟ يتجلى ذلك عبر مبادئ عملية وواعية:
أولاً: المراجعة اليومية. الاستراتيجية تبدأ بلحظة هادئة في نهاية كل يوم. لحظة تمسك فيها بمرآة روحك وتسأل: هل كانت قرارات وجداني اليوم متناغمة مع نداء الروح؟ أم كانت استجابة لضجيج ”حاجة السوق“؟ هذه المراجعة ليست لجلد الذات، بل هي عملية ”ضبط إعدادات“ مستمرة لـ ”نظام تشغيلنا“.
ثانياً: قوة الاختيار الصغير. الهوية الأصيلة لا تُبنى بقرار بطولي واحد، بل بآلاف القرارات الصغيرة المتراكمة التي تشكل، كقطع الفسيفساء، ملامح هويتنا الحقيقية.
ثالثاً: قبول الاحتكاك. أن تكون أصيلاً في عالم يروج للنسخ المقلدة هو بحد ذاته فعل مقاومة. جزء من الاستراتيجية هو أن نتقبل الاحتكاك مع العالم لا كدليل على فشلنا، بل كدليل على صدقنا.
ويمكننا أن نستعير من عالم الأعمال استعارتنا الأخيرة لنوضح جوهر هذه الاستراتيجية. ففي عالم الشركات، لا يمكن تحقيق هدف استراتيجي دون تحليل دقيق للوضع الراهن ورسم خارطة طريق واضحة. واستراتيجية الهوية التي نتحدث عنها تتبع نفس المنطق تمامًا: ”الوعي بالذات“ هو تحليلنا الصادق لذواتنا، و ”وضوح الهدف والغاية“ هو رسمنا لخارطة الطريق. كلاهما ضروريان للوصول إلى الغاية النهائية: تحقيق أصدق نسخة من ”أنت“.
في النهاية، تضع الحياة القلم في يد كل واحد منا، وأمامنا صحيفة أعمالنا. والهوية الحقيقية ليست سوى ذلك التوقيع في نهاية الصفحة. فإما أن يكون توقيعًا مهزوزًا ومقلَّدًا، نتاج خوف ورغبة في نيل رضا الآخرين. وإما أن يكون توقيعًا واثقًا وأصيلاً، نابعًا من مركز الكيان، لأنه الأثر الصادق لروحٍ عاشت بوفاء للأمر الأول الذي أوجدها.
فأي توقيع ستترك على صفحة وجودك؟
















