الصوت الأعلى من التصفيق... رحلة في أثر السؤال
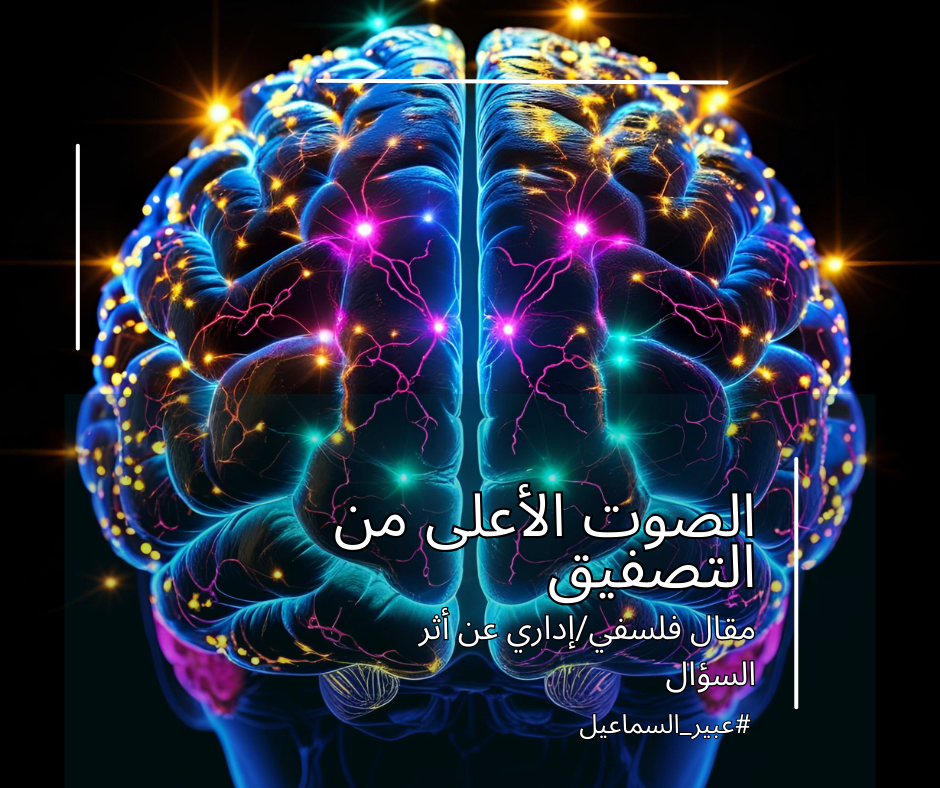
دماغٌ هائل، يمتد كقارةٍ شاسعة تحت قبو الجمجمة. معظم تضاريسه الرمادية يكسوها غبارٌ ناعم، غبار العادة واليقين الهادئ والمسلّمات التي لم تُمسّ قط. وحدها مساراتٌ قليلة، متآكلة من فرط الاستخدام، تلمع بضوءٍ خافت ومتكرر. هي دروب المهام اليومية، وطرق الاستجابات التلقائية، مسارات حياةٍ قد تمضي بأكملها دون أن تُختبر، تلك الحياة التي اعتبرها سقراط، كما دوّن تلميذه أفلاطون في حوار ”دفاع سقراط“، غير جديرة بأن تُعاش.
وفجأة، من عمقٍ مجهول، تنطلق ومضة. ليست كغيرها. نبضةٌ عصبيةٌ بلونٍ لم تألفه الخلايا، تسري في اتجاهٍ جديد، متحدّيةً الطرق المعبّدة. إنها لا تحمل معلومة، لا تحمل قرارًا جاهزًا. بل تحمل شيئًا أكثر بدائية وقوة: إنها تحمل سؤالاً. تلك الأداة التي اعتبرها فولتير في كتاباته، مثل ”القاموس الفلسفي“، المقياس الحقيقي للعقل، لا الإجابات التي يحفظها.
هذه الشرارة الصغيرة تعبر القارات المنسية، وحيثما مرّت، يتطاير الغبار، وتستيقظ خلايا كانت في سباتٍ عميق، وتتصل ببعضها للمرة الأولى، مطلقةً صرخة صامتة في الوعي: ”ولكن، ماذا لو؟“ أو ”لِمَاذا؟“. وفي تلك اللحظة بالذات، يُثبت الدماغ وجوده الحقيقي لنفسه، مرددًا صدى عبارة ديكارت الخالدة من كتابه ”مقال عن المنهج“: ”أنا أفكر، إذًا أنا موجود“.
فما الذي يملك القدرة على إطلاق هذه الشرارة فينا؟ ما هو ذلك الأثر الخارجي الذي لا يكتفي بتغذية ما هو حيّ، بل يجرؤ على إحياء ما قد مات في عقولنا؟ وكيف يمكن لهذه اللحظة الواحدة من التساؤل أن تعيد تشكيل مسار حياةٍ شخصية، أو مستقبل عملٍ بأكمله؟
عندما نهبط من قارة الدماغ إلى عالم الشركات، نجد أن الإدارة هي بالفعل الدماغ المركزي. لكن السؤال الأهم هو: أي نوع من الأدمغة هي؟ هل هي مجرد معالج فائق الكفاءة، يُشغّل برمجيات الأمس بكفاءة آلية، أم هي وعيٌ حي، قادرٌ على التساؤل عن وجوده وغايته؟ هنا يكمن الفارق بين الانقراض وما يُعرف اليوم في عالم الأعمال بـ ”الاستدامة“.
فالاستدامة في أعمق معانيها، وكما يطرح مفكرون مثل آري دي خوس في كتابه ”الشركة الحية“، ليست مجرد مصطلح بيئي أو اجتماعي، بل هي صفة الشركة ككيانٍ حي: القدرة على التعلم والإحساس بالواقع المتغير، والتساؤل المستمر عن ملاءمة استجابات الأمس لتحديات اليوم، وتكييف الوجود لضمان المستقبل. إنها حالة الوعي التي تمنع الجمود. ومن هنا يأتي الخطر الأعظم في أوقات الاضطراب، كما حذّر حكيم الإدارة بيتر دراكر، ”ليس الاضطراب نفسه، بل التعامل معه بمنطق الأمس“.
1. السؤال من الأعلى: الدماغ يوقظ نفسه «لحظة ”لماذا؟“»
هذه هي لحظة القيادة الحقيقية. حين يتوقف القائد عن سؤال ”كيف؟“ ويبدأ بسؤال ”لماذا؟“. هذا السؤال، الذي بنى عليه المفكر الإداري سايمون سينك فلسفته في كتاب ”ابدأ بلماذا“، هو محاولة الدماغ الإداري للخروج من دائرة التفكير المغلقة. إنه إدراكٌ واعٍ للمقولة الشهيرة التي تُنسب لآينشتاين وتلخص الكثير من فكره: ”لا نستطيع حل مشاكلنا بنفس العقلية التي أوجدتها“. هذا السؤال لا يطلب تقريرًا، بل يطلق رحلة بحث عن ”الروح“ والمعنى في جسد الشركة، وهو ما يميز القائد عن المدير.
2. السؤال من الأسفل: الجسد يرسل إشارة «لحظة ”الأندون“»
هنا يكمن سر الكائنات الحية القادرة على البقاء. الفيلسوف وعالم الرياضيات نوربرت فينر، مؤسس ”علم التحكم الآلي“، بنى نظريته على أهمية ”التغذية الراجعة“ لبقاء أي نظام ذكي. السؤال الصاعد من الموظف هو أهم أشكال هذه التغذية الراجعة.
ولعل أروع تجسيد واقعي وحقيقي لهذه الفكرة، قصة أصبحت أسطورة في علم الإدارة، تأتي من نظام إنتاج تويوتا. ففي مصانعها، خلال فترة الخمسينيات والستينيات، وفي خضم الثورة الإدارية التي قادها المهندس تاييتشي أونو، تم تطبيق مبدأ ثوري. تخيّل مشهد خط التجميع الهائل الذي لا يتوقف، وفجأة، يقوم عامل بسيط بسحب حبل فوقه يسمى ”حبل الأندون“ «Andon Cord». في تلك اللحظة، تتوقف الآلات العملاقة بالكامل. لماذا؟ لأن هذا العامل لديه سؤال أو لاحظ مشكلة. في فلسفة تويوتا الحقيقية، هذه الإشارة القادمة من ”العصب الطرفي“ ليست إزعاجًا، بل هي هدية ثمينة تمنع كارثة أو تكشف فرصة لتحسين لا يقدر بثمن.
الشركة التي لا تملك ”حبل أندون“ ثقافيًا، والتي تعاقب الموظف الذي يطرح سؤالاً ”مزعجًا“، هي شركة قطعت جهازها العصبي. دماغها معزول، لا يشعر بألم أطرافه أو ما تلمسه، ومصيرها الفشل الحتمي.
فإذا كانت الأسئلة، تلك النبضات العصبية للحياة، تسير في اتجاهٍ واحد فقط، سواءً من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، فهل تكون هذه استدامة حقيقية، أم مجرد صدى طويل لقرارٍ قد مات بالفعل؟
وها هو السؤال، كصدى لأفكارنا، يعود ليطرق أبواب وعينا: هل الشرارة محصورةٌ في هيئة الاستفهام الصريح؟ هل الكاتب الذي يهدف لإيقاظ العقل مُجبرٌ على إنهاء سيمفونيته بعلامة استفهام مدوية؟ أم أن هناك أنغامًا أخرى، أكثر خفوتًا، قادرة على هزّ أركان الروح؟
إن التأمل في هذا يجرنا إلى مساحة ضبابية، حيث تتلاشى جاذبية الإجابات. في هذا الفضاء، قد نلاحظ كُتّابًا لا يكونون قاذفين للشرر، بل ”مهندسين للفراغ“؛ فنانين يدركون أن بعض أقوى الأسئلة لا تُلفظ، بل تُولد في الفجوات التي تُترك عمدًا. قد يجسدون هنا ما أسماه الشاعر الإنجليزي جون كيتس بـ ”القدرة السلبية“ «Negative Capability»، وهي تلك الحالة العبقرية التي يستطيع فيها المرء أن يمكث في الشك والغموض، دون تسرع عصبي نحو الحقيقة أو اليقين.
أو قد يلجأ الكاتب إلى فن الصمت، إلى ما يُعرف في فلسفة الجمال اليابانية بمفهوم ”الما“ «Ma»، وهو ليس مجرد فراغ، بل هو ”الفضاء المشحون بالاحتمالات“. إنه الصمت بين النغمات الذي يعطي للموسيقى معناها. النص هنا لا ينتهي بسؤال، بل ينتهي بصمتٍ مدوٍ، صمت يفرض على وعيك أن يملأه بهمهماته وتساؤلاته الخاصة.
وفي أحيانٍ أخرى، تكون الشرارة نشازًا خفيًا في سيمفونية متكاملة. فكم قرأنا عن عوالم مثالية قدمها كُتّاب، لكنهم تركوا فيها تفصيلاً واحدًا يثير القلق. هذا يخلق ذلك الشعور الذي حلله سيغموند فرويد بعمق في مقاله ”الغريب“ «The Uncanny»، حيث المألوف والمريح فجأة يصبح مصدر قلق غامض وغير مسمى.
فهل السؤال إذن شكلٌ له حدود مرسومة بعلامة استفهام؟ أم هو حالةٌ من الوعي يمكن استدعاؤها بالغموض والصمت والجمال الناقص؟ وأين تكمن العبقرية حقًا؟ هل هي في صوت السؤال نفسه، أم في ذلك الصمت المشحون الذي يسبقه ويجعله... حتميًا؟
عندما تصل رحلة الفكر إلى نهايتها، لا تجد أرضًا صلبة من الإجابات، بل محيطًا شاسعًا من الأسئلة الأكثر عمقًا. فهل كانت رحلتنا هذه بحثًا عن أثر السؤال، أم كانت هي ذاتها أثرًا للسؤال فينا؟
يبدو أن المسار، كلما تعمقنا فيه، يعود بنا إلى نقطة البداية في تاريخ الفلسفة؛ إلى حكمة سقراط التي خلدها أفلاطون، وهي أن ذروة المعرفة ليست في امتلاك اليقين، بل في إدراك حجم جهلنا بصدق. ويتردد صدى هذه الفكرة في همس الشعراء، كنصيحة الشاعر راينر ماريا ريلكه في ”رسائل إلى شاعر شاب“، حين دعا إلى ألا نبحث عن الإجابات، بل أن ”نعيش الأسئلة الآن“.
فهل نحن بذلك نقترب من روح عصرنا العلمي نفسه، الذي يبدو كأنه لم يعد يبحث عن يقين مطلق، بل عن فضاء أوسع من الاحتمالات؟ وهل تكون نهاية الرحلة إذن ليست إجابة تُكتسب، بل تحولٌ يصيب الباحث نفسه؟
يقال إن الرحلة التي تعود إلى نقطة بدايتها ليست سوى دورانٍ في دائرة مفرغة. فهل كانت رحلتنا هذه دائرة مفرغة حقًا؟ أم أن الدائرة التي تعود إلى نقطة البداية وقد تغيرت نظرتنا إليها، هي ليست دائرة، بل لولبٌ يرتقي بنا إلى الأعلى؟
وفي نهاية المطاف، هل تُقاس قيمة وجودنا حقًا بما جمعناه من إجابات مُطمئنة، أم بمدى شجاعتنا على أن نحيا ونتنفس داخل أسئلتنا الكبرى التي لا جواب لها؟
















