فكرة تعارف الحضارات من الميلاد إلى الامتداد
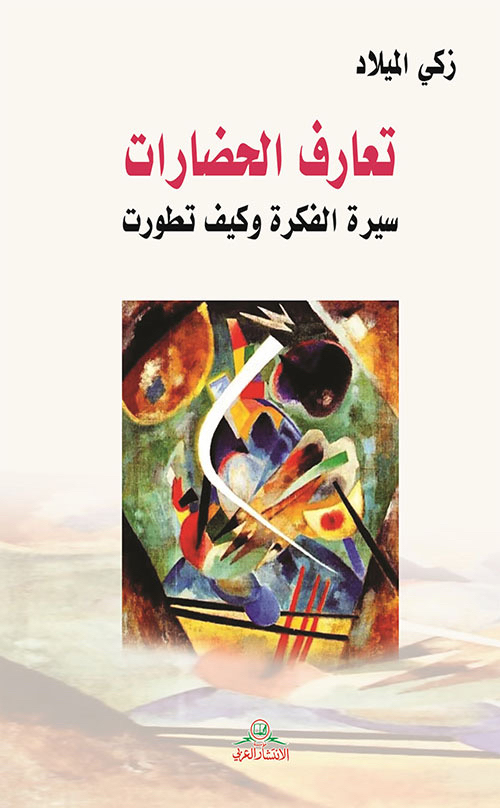
• الكتاب: تعارف الحضارات: سيرة الفكرة وكيف تطوَّرت.
• المؤلف: زكي الميلاد.
• الناشر: مؤسسة الانتشار العربي - بيروت.
• سنة النشر: الطبعة الأولى، 2024 م.
• الصفحات: 227 صفحة.
ليس كتاب «تعارف الحضارات: سيرة الفكرة وكيف تطورت» مجرد مساهمة فكرية في حقل العلاقة بين الثقافات والحضارات، بل هو تأريخ فلسفي لفكرة وُلِدت من صلب الوعي العربي المعاصر، ونشأت على يد المفكر زكي الميلاد، الذي أبدع هذا المفهوم سنة 1997 م، وجعل منه نواة مشروعه المعرفي الممتد.
منذ تلك اللحظة التأسيسية لم يتعامل الميلاد مع «تعارف الحضارات» بوصفها استجابة آنية لسياقات دولية مضطربة، بل بوصفها أفقًا معرفيًّا جديدًا، وإعادة نظر جذرية في طرائق فهم الآخر، والتفاعل معه، خارج ثنائيات الهيمنة والخضوع، أو الصراع والإنكار. لقد كانت هذه الفكرة بمثابة إزاحة فكرية عن المركزيات المتعالية، وإقامة خطاب بديل يُعيد تشكيل العلاقة بين الحضارات، على أسس من التعارف، لا التنافر، ومن الانفتاح، لا الانغلاق.
في مقدمة الكتاب يبوح الميلاد بسيرة هذه الفكرة من لحظة ولادتها الأولى، ويكشف عن الجهد الاجتهادي الذي بذله كي تكتمل وتستوفي شروطها الفكرية والبيانية، موقنًا بأن الأفكار الكبرى لا تخرج إلى الوجود دفعة واحدة، بل تنمو، وتتطوّر، وتُصقل عبر مسارات متعدِّدة من الفهم والتمحيص والتجربة. ومن هنا، فإن هذا العمل لا يُقدّم «تعارف الحضارات» كمفهوم عائم أو شعار خطابي، بل كبنية فلسفية حيَّة، تجسّدت وتطوَّرت ضمن سياق ثقافي عربي، وبقيادة مؤلفها الأول.
يتوزَّع الكتاب على مقدمة وسبعة فصول، يتتبع من خلالها الكاتبُ خطّ تطوّرِ الفكرة منذ ميلادها النظري، إلى لحظة دخولها الحقل العلمي والجامعي؛ من النشر الأكاديمي إلى الرسائل العليا، ومن التأليف الفردي إلى المناهج التعليمية، ثم إلى الأنشطة الفكرية الجمعية، وصولًا إلى الفصول التي يناقش فيها التحديات النقدية التي وُجّهت للفكرة.
لكن القيمة الفلسفية لهذا الكتاب لا تكمن فقط في توثيق المسار، بل في قدرته على تحويل الفكرة من لحظة ابتكار فردي إلى مسار تشاركي ومجال بحثي آخذ في التبلور، يطمح إلى أن يكون بديلًا معرفيًّا عن خطاب «صدام الحضارات» الذي هيمن لعقود على الرؤية الجيوثقافية للعالم.
ولعل ما يضفي على هذا المشروع بُعده الأنطولوجي العميق، هو استناده إلى جذر قرآني صلب، يتمثَّل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [1] . وهي الآية التي تحوَّلت عند الميلاد إلى أصل تأسيسي لفهم فلسفي جديد للوجود الإنساني، يقوم على التعارف لا التصارع، وعلى الاعتراف لا الإقصاء.
هكذا، يُقدِّم زكي الميلاد في هذا العمل الرصين سيرةً لفكرة وُلِدت من قلب سؤال حضاري مُلِحّ، ونضجت في فضاء فكري عربي، وهي اليوم في طريقها لأن تتحوَّل إلى أحد أبرز مفاتيح قراءة العالَم، من منظور إنساني جامع، لا من منظور متمركز حول الذات.
يتناول هذا الفصل رصدًا تحليليًّا دقيقًا لملامح حضور فكرة «تعارف الحضارات» في النشر الفكري العربي، وتحديدًا في المقالات المنشورة في الدوريات المحكّمة والمجلات الفكرية ذات الطابع الثقافي. وقد اعتمد المؤلف على تحليل (19) مقالة، نُشرت أكثرها في مجلة «الكلمة» التي يرأس تحريرها، فيما توزَّعت الأخرى على مجلات متنوِّعة. ويرى زكي الميلاد أن هذا التراكم المعرفي لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه، إذ يُعَدّ - بحسب تعبيره - «تراكمًا فكريًّا جادًّا»، مما يعني أن الفكرة لم تبقَ حبيسة الشعارات، بل بدأت تأخذ طريقها نحو التأسيس المعرفي.
وفي هذا السياق، تحدَّث الميلاد في الصفحة (15) قائلًا: «بهذه الخطوة تكون مجلة الكلمة قد حقَّقت لفكرة التعارف تراكما فكريًّا جادًّا، لمن يريد متابعة هذه الفكرة، والتعرُّف إليها، والتواصل معها، ومعرفة كيف تطوَّرت».
وقد حرص الميلاد في هذا الفصل على تصنيف المقالات وفق محاور واتجاهات متعدِّدة، أبرزها:
- المقالات التي تُركِّز على الأساس النظري لمفهوم التعارف.
- المقالات التي تقارن بين «تعارف الحضارات» و«صراع الحضارات».
- المقالات التي تعالج الإسقاطات التطبيقية للفكرة في مجالات التعليم، والإعلام، والدبلوماسية الثقافية.
كما يُظهر الميلاد كيف أن بعض الباحثين العرب بدؤوا يتبنَّون المفهوم بوصفه إطارًا تفسيريًّا بديلًا، يعكس قيم التواصل والتفاعل، بدلًا من الانغلاق والتناحر.
ضمّ الفصل الثاني من الكتاب إحدى عشرة مقالة علمية نُشرت في مجلات أكاديمية عربية مختلفة، تتمحور جميعها حول فكرة «تعارف الحضارات»، وقد حرص زكي الميلاد على تقديمها والتعليق عليها في هذا الفصل الممتد من الصفحة (55) إلى الصفحة (78). ويكتسب هذا الفصل طابعًا توثيقيًّا وتحليليًّا في الآن ذاته، إذ يرصد الكاتب كيف بدأت الفكرة تشقُّ طريقها في الحقل الأكاديمي العربي، وكيف تمَّ التعامل معها من قِبَل عدد من الباحثين العرب في مجالات الفكر والفلسفة والدراسات الحضارية.
ويُمثِّل هذا الفصل حلقة مفصلية في مسار سيرة فكرة «تعارف الحضارات»؛ لأنه يُظهر لنا الانتقال من التنظير الفردي للفكرة إلى تداولها في الوسط العلمي والأكاديمي، بما يدل على نموها وانتشارها وتحوّلها إلى مجال بحثي قابل للمساءلة العلمية والمقاربة المعرفية.
ويُلاحظ أن المقالات التي تمَّ عرضها تنتمي إلى مجلات متعدِّدة ومتنوِّعة الاختصاصات، مما يعكس سعة انتشار الفكرة وتعدُّد الاهتمامات التي تتقاطع معها. كما أن أصحاب هذه المقالات ينتمون إلى خلفيات فكرية وأكاديمية مختلفة، ما يُضفي على الفصل غنى وتنوُّعًا في الرؤى، ويُؤكِّد أن الفكرة بدأت تخرج من طور التلقِّي الفردي إلى طور التفاعل الجماعي والمجتمعي.
ويشير زكي الميلاد إلى أن بعض المقالات تناولت فكرة تعارف الحضارات من زاوية التاريخ الثقافي، بينما اقتربت منها أخرى من باب الفلسفة السياسية، أو الخطاب الديني، أو حتى الفكر الاستراتيجي. وهذه التعدُّدية في المقاربات تبرهن على حيوية الفكرة ومرونتها، وعلى قدرتها على الاشتغال ضمن حقول متعدِّدة.
ولم يكتفِ الميلاد بعرض المقالات، بل قام بتعليقات دقيقة ومحايدة، عليها، محاولًا إبراز الجوانب التي أسهمت في توسيع أفق الفكرة، أو تلك التي انحرفت أحيانًا عن جوهرها المفهومي. وقد أبدى اهتمامًا خاصًّا بالمقالات التي تعاملت مع فكرة التعارف باعتبارها بديلًا نقديًّا لصدام الحضارات، أو تلك التي قرأتها في ضوء النص القرآني واستندت إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [2] .
كما أشاد الميلاد بالمقالات التي قدَّمت إضافات معرفية جديدة، أو التي اقترحت مفاهيم موازية ك«الحوار الحضاري» و«الشراكة الثقافية»، لكنه في المقابل، أشار إلى بعض التكرارات في الخطاب، وإلى غياب التأصيل المنهجي في بعض المساهمات، داعيًا إلى مزيد من الدِّقَّة في استخدام المفهوم وضبط علاقته بالمفاهيم المجاورة.
وما يُميِّز هذا الفصل أنه يُظهر كيف أصبحت فكرة تعارف الحضارات موضوعًا معرفيًّا متداولًا، وليس مجرَّد تصوُّر نظري معزول. وقد أشار الميلاد إلى أن هذه المرحلة تُمثِّل أحد مؤشرات «النضج المفهومي» للفكرة، بما أنها بدأت تُثير اهتمام الباحثين والدارسين، وتندرج في خريطة البحوث الجادَّة.
ومما يلاحظ، أن هذا الفصل يُعدّ من أكثر فصول الكتاب حيويةً وتوثيقًا لحركة الفكرة في المجال الأكاديمي؛ لأنه يرسم صورة عن مسار «تعارف الحضارات» من لحظة الإطلاق إلى لحظة التلقِّي والتداول العلمي. كما تكمن أهميته في أنه يضع بين أيدينا «أرشيفًا فكريًّا» من النصوص والمقالات التي تُسهم في بلورة المفهوم وصقله، ويُقدِّم في الوقت نفسه ملاحظات نقدية رصينة من طرف زكي الميلاد الذي يُعدُّ الأب الروحي لهذا المفهوم في الفكر العربي المعاصر.
في القسم الثالث وتحديدًا ما بين الصفحات (80) و(104)، يعرض زكي الميلاد جهدًا توثيقيًّا معرفيًّا مهمًّا، حيث يستعرض بإيجاز مركّزٍ حضور فكرة «تعارف الحضارات» في عدد من المؤلفات العربية، بلغت ثمانية وعشرين كتابًا، تنتمي إلى باحثين ومفكرين من خلفيات معرفية متنوّعة، توزَّعت أعمالهم بين تركيز صريح على هذه الفكرة كمحور رئيس، أو تناول جزئي لها ضمن فصل أو مبحث أو فقرة عارضة. ويُلَاحظ أن هذا الجهد يعكس تحوُّلًا نوعيًّا في اتجاهات الفكر العربي، من مجرّد التفاعل مع ثنائية «تصادم الحضارات» و«حوار الحضارات»، إلى بلورة رؤية أكثر عمقًا وإنسانية تقوم على التعارف كأفق تأويلي ومفهومي جديد.
ما يلفت الانتباه في هذه المؤلفات هو طابعها الاستباقي أو الاستدراكي، فهي إما تطرح الفكرة من موقع التجاوز النقدي للمفاهيم السائدة، أو تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الثقافات من منظور يُعيد الاعتبار للمشترك الإنساني ولضرورات المعرفة المتبادلة.
إن استحضار الميلاد لهذه الكتب لا يقتصر على مجرَّد الإشارة الببليوغرافية، بل يتضمَّن وعيًا بأن تراكم هذه النصوص يُمثّل إرهاصًا نظريًّا لفكرة بدأت تكتسب ملامحها المفاهيمية في الساحة الفكرية العربية. فبعض هذه الكتب ارتكز على معالجة فلسفية، فيما اتّجه بعضها الآخر إلى قراءات دينية أو تحليل تاريخي أو نقد ثقافي، مما يُظهر أن «تعارف الحضارات» بدأت تتحوَّل إلى حقل معرفي متعدِّد المشارب، لا ينتمي إلى تخصُّص بعينه، بل يُطلُّ من نوافذ متقاطعة.
وقد كان هذا العرض بمثابة خريطة أولية تساعد على رصد الامتدادات التي أصبحت الفكرة تحتلها في التفكير العربي الراهن. فبدلًا من أن يُختزل النقاش في استجابات دفاعية أمام مقولات الغرب حول الصراع أو الحوار، فإن هذه المؤلفات تسعى إلى تأسيس خطاب مستقلّ، يجد في «التعارف» مفهومًا قرآنيًّا قابلًا للتوسعة الحضارية والاشتغال النظري. وبذلك، يتحوَّل المفهوم من مجرَّد ردِّ فعل إلى مشروع فكر، يفتح أمام المثقفين العرب أفقًا للتأصيل والانخراط في النقاش الكوني، لا من موقع التبعية، بل من موقع المشاركة الإبداعية.
إن ما قام به زكي الميلاد في هذا الفصل يضيء على سيرة الفكرة من زاويا مختلفة، حيث تصبح النصوص العربية التي تناولت «تعارف الحضارات» شاهدة على أن السياق العربي لم يكن غائبًا عن هذا التحوُّل في التفكير العالمي، بل كان شريكًا فيه، ولو بصيغ متفاوتة. وتأتي أهمية هذا الجهد من كونه لا يستعرض النصوص كحالات معزولة، بل يربطها بسياق تطوُّر الفكرة ويجعل منها دليلًا على أن العقل العربي بدأ يستعيد موقعه كمبادر لا كمستجيب فقط، كمساهم في البناء النظري لا كمُتلَقٍّ سلبي.
ومن هنا، فإن تعارف الحضارات - كما تعكسه هذه الكتب - لم يعد مجرَّد مفهوم عابر أو دعوة خطابية، بل تحوَّل إلى مشروع معرفي وأخلاقي يُعيد تشكيل العلاقة بين الذات والآخر، ويمنح للثقافة العربية أفقًا كونيًّا في زمن يزداد فيه الانغلاق والتقوقع.
بهذا المعنى، يغدو الفصل بمثابة دليل استكشافي يساعد المهتمين بالفكرة، من دارسين ومفكرين وطلبة دراسات عليا، إلى التعرُّف على الإنتاج الفكري الذي ساهمت في تعميق وتطوير هذا المفهوم. كما يمنحهم مدخلًا إلى تعدُّدية المقاربات التي عالجت الموضوع، سواء من منظور فلسفي، أو لاهوتي، أو سوسيولوجي، أو حضاري شامل، ويكشف عن تراكُمٍ غير ظاهر من الكتابات التي لم تُسلط عليها الأضواء بشكل كافٍ من قبل.
إن هذه المساهمة تجعل من الفصل أداة عملية مكمّلة للبُعد النظري للكتاب، فهو لا ينحصر في التنظير المجرَّد، بل ينفتح على الحقول التطبيقية والمراجع المفيدة، مما يعزّز من قيمة الكتاب لدى القارئ المتخصِّص، ويؤسِّس لإمكانية بناء مكتبة عربية تُعنى بهذا المفهوم، تكون مرجعًا مستقبليًّا لمن أراد أن يشتغل على «تعارف الحضارات» بجدية وعمق.
في الفصل الرابع ينتقل زكي الميلاد إلى مساحة جديدة في تتبّع مسار حضور فكرة «تعارف الحضارات»، وهي المجال الأكاديمي الجامعي العربي، وتحديدًا في رسائل الماستر والماجستير والدكتوراه، وهي الحاضنة التي تُعِدّ الكوادر العلمية والفكرية، وتشكّل خرائط الوعي النظري والمعرفي لدى الأجيال القادمة. ومن خلال تصنيفه للرسائل الجامعية إلى نمطين: أحدهما محوري تتناول فيه الفكرة كموضوع أساسي، وآخر غير مباشر يظهر فيه المفهوم ضمنيًّا أو عرضًا، ينجح المؤلف في تقديم قراءة دقيقة لحضور هذه الفكرة في فضاء المعرفة العربية المؤسسية.
غير أن ما يسترعي الانتباه، ويتجاوز الطابع الوصفي نحو تأمُّل دلالي أعمق، هو التفاوت في خرائط الاهتمام بين الدول. فحين نقوم بتحليل هذه الخرائط، يظهر أن الجزائر تتصدَّر هذا الحقل بشكل ملحوظ، سواء في الأطروحات التي تناولت الفكرة بشكل محوري «سبع أطروحات»، أو التي تناولتها بشكل غير مباشر «سبع أطروحات أيضًا»، ما يجعل مجموع مساهماتها أربع عشرة رسالة جامعية من أصل (24) تمّ رصدها.
هذه الأرقام لا تنتمي فقط إلى الإحصاء، بل تُعبّر عن وعي أكاديمي يتبلور داخل الجزائر حول أهمية هذا المفهوم بوصفه مدخلًا إلى فهم العلاقات الحضارية، والبحث في إمكانات التلاقي بين الثقافات، بعيدًا عن منطق الهيمنة أو الصراع.
في المرتبة الثانية تأتي المغرب بـ «ثلاث رسائل»، اثنتان منها في النمط المحوري، وواحدة في النمط غير المباشر، ما يعكس اهتمامًا متناميًا. وتليها العراق برسالتين، ثم كل من سوريا، السودان، فلسطين، تونس، وقطر برسالة واحدة لكل دولة.
إن هذا التوزيع يُفصح عن واقع متباين في التلقّي المؤسسي للفكرة، ويعكس في الآن ذاته مدى رسوخ أو هشاشة البنية المفهومية لتعارف الحضارات في السياق الجامعي لكل دولة.
وإذا كان الاهتمام الجزائري في هذا المجال مؤشرًا على تحوُّل الفكرة إلى محور اهتمام بحثي مستقر داخل المنظومة الأكاديمية الجزائرية، فإن ذلك أيضًا يفتح أسئلة أخرى: ما هي الأسباب التي جعلت من الجزائر مركز ثقل في هذا الحقل؟ هل يتعلَّق الأمر بنشاط الباحثين في الفلسفة والعلوم الاجتماعية؟ أم بخصوصيات ثقافية وتاريخية تُعيد تشكيل علاقتها بالآخر ضمن أفق التعارف لا التصادم؟
مهما تكن الإجابات، فإن حضور الجزائر على هذا النحو يُشير إلى أن تعارف الحضارات ليس مفهومًا عابرًا في بعض الأوساط، بل أصبح فضاءً مفاهيميًّا يُعاد التفكير من خلاله في العلاقة بين الذات والآخر، وبين الشرق والغرب، وبين ماضي التفاعل الحضاري ومستقبله.
وعلى الرغم من أنّ باقي الدول لم تبلغ بعدُ هذا المستوى من التراكم، إلَّا أن مشاركتها، ولو المحدودة، تؤشّر إلى بذور قابلة للنمو إذا ما توافرت الشروط المؤسسية والمعرفية لذلك.
إنّ الفكرة كما تتجلَّى في هذا الفصل، لم تعد حبيسة النخب الفكرية، بل نجدها تتسلل تدريجيًّا إلى البنية العميقة للمعرفة الجامعية، لتُصبح جزءًا من أفق تربوي ومعرفي يسعى إلى إعادة بناء العالم لا فقط عبر الحوار، بل عبر التعارف، بوصفه أعمق من الحوار، وأرحب من مجرَّد التسامح.
وعند التأمُّل في توزيع التخصُّصات التي تناولت فكرة تعارف الحضارات في الفصل الرابع، سواء بشكل محوري أو غير مباشر، تتكشَّف لنا خريطة دلالية دقيقة تُعبّر عن كيفية تلقّي الحقول المعرفية المختلفة لهذه الفكرة، وعن مدى قابليتها لاستيعابها وتحويلها إلى موضوع للبحث والتحليل الأكاديمي.
ففي المرتبة الأولى بفارق واضح، يأتي تخصُّص الفلسفة، حيث تمَّ رصد «11 أطروحة، 8 محورية و 3 غير مباشرة». وليس من المستغرب أن تحتلَّ الفلسفة هذه المرتبة المتقدِّمة، ففكرة تعارف الحضارات بطبيعتها تستند إلى أسس تأمُّلية، ومسارات معرفية تنطلق من سؤال الكينونة والآخر والاختلاف والتواصل. فالفلسفة هي الحقل الأقدر على مساءلة هذه المفاهيم في عمقها، وعلى التعامل مع التوتُّرات التي تنشأ من التلاقي الحضاري. كما أنها تمتلك أدوات تحليلية تساعد على تفكيك الثنائية التقليدية بين الصراع والحوار، وإعادة بناء رؤية ثالثة تنفتح على التعارف كمفهوم أكثر رحابة وإنسانية.
تليها العلوم السياسية بـ «6 أطروحات» جميعها غير مباشرة، وهو أمر طبيعي أيضًا؛ لأن العلاقات بين الحضارات كثيرًا ما تُستحضر في إطار الجدل الجيوسياسي والاستراتيجي. غير أن حضور الفكرة هنا ظل هامشيًّا أو عرضيًّا، ولم ترقَ إلى أن تكون موضوعًا مركزيًّا، ما قد يُفسَّر بكون العلوم السياسية تميل إلى التعامل مع الوقائع من منظور براغماتي وتحليلي مباشر، ولا تدخل غالبًا في تعقيدات المفاهيم القيمية ما لم تكن مدفوعة بهاجس فلسفي أو أنثروبولوجي.
أما الدراسات الإسلامية فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ «3 أطروحات، 2 محورية و 1 غير مباشرة». وهو حضور لافت ومهمّ؛ لأن تعارف الحضارات في السياق الإسلامي ليس مجرَّد فكرة حديثة، بل يرتبط بجذر قرآني واضح في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [3] غير أن عدد الأطروحات، ما يزال قليلًا، ما يُشير إلى أن هذا الحقل لم يستثمر بعدُ طاقاته الكامنة في استنطاق المفهوم وتفعيله ضمن قراءاته التراثية والمعاصرة، وهو ما يدعو إلى مزيد من البحث والتأصيل من داخل المرجعية الإسلامية نفسها.
وتأتي بعد ذلك تخصُّصات أخرى بشكل أكثر تفرّقًا: علوم الاتصال أطروحة واحدة - محورية من السودان. ثم علم الاجتماع، أصول الدين، العلوم الثقافية، الأديان وحوار الحضارات، العلوم الإسلامية، وكلها سجَّلت أطروحة واحدة لكل منها في النمط غير المباشر. وهذه التخصُّصات، رغم تنوّعها، لم تتعامل مع الفكرة إلَّا عَرضًا، ما يُشير إلى أن فكرة تعارف الحضارات لم تدخل بعدُ بقوة إلى قلب اهتمامات هذه الحقول، وربما تُعاني من ضعف التأصيل النظري، أو من غياب الوعي المؤسسي بقيمتها المعرفية.
وهكذا يتَّضح أن ترتيب التخصُّصات لم يكن اعتباطيًّا، بل هو نتيجة لطبيعة كل حقل، ولمدى جاهزيته النظرية لاستقبال الفكرة. وهذا ما يجعل من هذا الفصل في كتاب زكي الميلاد خريطة معرفية حقيقية يمكن البناء عليها لتوسيع الفضاء البحثي لفكرة تعارف الحضارات في الجامعات العربية.
في ضوء هذا التحليل، يبدو أن فكرة تعارف الحضارات ليست مجرَّد فكرة تُدرَس داخل تخصّص أو اثنين، بل هي مرآة لتحوُّلات أعمق، تعكس طبيعة المرحلة التي تمرّ بها المجتمعات العربية بين الانغلاق والانفتاح، والجامعات التي تمنح هذه الفكرة حيِّزًا أكبر، هي في الحقيقة تبحث عن نماذج للعيش المشترك والسِّلْم الثقافي، من داخل الحقول المعرفية التي تملك قدرة على إعادة تشكيل الوعي العام.
في أفقٍ معرفي يتجاوز حدود النظرية المجرَّدة، يرصد زكي الميلاد في هذا الفصل تحوّل فكرة تعارف الحضارات من كونها أطروحة فكرية إلى نواة تشكّلٍ مؤسسي في الفضاءات التربوية والتعليمية داخل العالم العربي. لم تعد هذه الفكرة تسكن حيِّز النخبة الثقافية، بل غدت تُخاطب العقل التربوي العربي، وتطلب له تشكيلًا جديدًا، أكثر انفتاحًا، وأكثر استعدادًا للاعتراف بالآخر بوصفه شريكًا في إنتاج المعنى لا خصمًا في ساحة الصراع.
يستهل الميلاد تحليله من مشهد التعليم الثانوي، حيث تبرز الإمارات العربية المتحدة كنموذج طليعي في إدماج مفهوم التعارف الحضاري ضمن المقرَّرات الدراسية، لا سيما في مادة التاريخ. وهنا، لا يُعاد تقديم التاريخ كوقائع صراعية أو غنائم أيديولوجية، بل كمجالٍ لإعادة إنتاج السردية، بما يسمح بتحويله إلى منصة لتلاقي الحضارات، لا لتقابلها العدائي.
ثم تتَّسع العدسة لتشمل التعليم العالي، حيث يزدهر حضور الفكرة في الجامعات الجزائرية. في جامعات سطيف، الشلف، الأغواط، وعنابة، لم تُعامل تعارف الحضارات كموضوع طارئ، بل كمبحث فلسفي مستقل، أُدرِج ضمن برامج الماستر، بإشراف وزارة التعليم العالي، التي تبدو وكأنها تسعى إلى تأصيل رؤية حضارية داخل الحقل الفلسفي ذاته. وللفلسفة هنا خصوصيتها، فهي بطبيعتها خطاب اعتراف، وتجربة في مساءلة الهوية، ومجالٌ خصب لفهم الذات عبر الآخر، والآخر عبر الذات.
ولا تلبث الفكرة أن تتجاوز الفلسفة، فتسري في عروق تخصُّصات معرفية أخرى: التاريخ في جامعة الشارقة، علوم الشريعة في جامعة قطر. ما يُشير إلى طابعها التداخلي، وإلى قابليتها للتكيّف داخل منظومات معرفية متباينة، من دون أن تفقد نواتها الإنسانية الجامعة. إنها فكرة تحمل من المرونة ما يجعلها تتجاوز الفواصل بين المعارف، ومن العمق ما يجعلها تستقر في جوهر كل علم يبتغي فهم الإنسان.
أما في السعودية، فتمضي الفكرة إلى مستوى تطبيقي من خلال أكاديمية الحوار التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، حيث لا تظل فكرة تعارف الحضارات فكرة للتأمُّل، بل تتحوّل إلى مهارة للحياة، تُدرّس في دورات تدريبية، تحت عنوان «الحوار الحضاري». وهنا نلمس تحوّلًا من التنظير إلى التمرّن، ومن القول إلى الفعل.
كل هذه المبادرات، برغم تنوُّعها، تشي بأن الفكرة لم تعد اجتهادًا فرديًّا أو نزعة خطابية، بل مشروعًا ثقافيًّا استراتيجيًّا يتسلل إلى بنية التعليم، ويُعيد تشكيل الوعي المؤسسي العربي. صحيح أن السير غير منتظم، وأن البلدان ليست على درجة واحدة من التفاعل، لكن الاتّجاه العام يميل نحو تهيئة العقل العربي المعاصر ليكون أكثر استعدادًا للمجاورة الحضارية، وأكثر استعدادًا لتعلّم لغات الاعتراف.
في زمن يعجُّ بالتوتُّرات، وتزداد فيه صور «الآخر» تشوُّهًا وريبة، لا يبدو تعارف الحضارات مجرَّد ترف ثقافي، بل خيارًا أنطولوجيًّا وأخلاقيًّا، ورهانًا على تأسيس وعي عربي لا يرى في ذاته «ذاتًا مطلقة»، بل مرآةً تتعدَّد فيها صور الإنسانية، من دون أن تضيع. إنها، بعبارة فلسفية: محاولة لتخليص الذات من سجنها الأحادي، وفتحها على إمكانات أرحب للكينونة، في عالمٍ لا ينجو فيه أحد بمفرده.
وما نستخلصه هو التحوُّل من الفكرة إلى المؤسسة، حيث أصبحت فكرة تعارف الحضارات جزءًا من النسق المؤسسي التربوي في العالم العربي، بعدما كانت مجرَّد خطاب فكري نخبوي. تجلَّت الفكرة في مجالات معرفية متعدِّدة «فلسفة، تاريخ، شريعة، تدريب»، ما يدل على مرونتها، وعمقها الإنساني القادر على تجاوز الحواجز التخصصية.
وقد شكّل الحقل الفلسفي في الجزائر حاضنة متميِّزة للفكرة، بما للفلسفة من قدرة على مساءلة المفاهيم، وتفكيك التمركزات الهوياتية، وبناء جسور التواصل بين الذات والآخر. أما النموذج السعودي فيُبيِّن أن الفكرة لم تبقَ حبيسة المقررات، بل تحوَّلت إلى مادة تدريبية، تهدف إلى إنتاج مهارات عملية في التواصل الحضاري، وهو ما يعكس نضجًا في فهم متطلَّبات التغيير المجتمعي.
وجميع النماذج تشترك في قناعة ضمنية بأن إصلاح العلاقة مع الآخر يبدأ من المدرسة والجامعة، أي من إعادة تأهيل العقل العربي على أسس جديدة: التسامح، الاعتراف، التفاهم. ورغم هذه المبادرات، لا يزال المشروع في طور التشكّل، ويحتاج إلى مزيد من التأصيل الفلسفي، والدعم المؤسسي، والتوسيع الجغرافي والمعرفي، حتى يصير فاعلًا حقيقيًّا في بلورة هوية عربية منفتحة ومعاصرة.
إن فكرة تعارف الحضارات تُعدُّ من المفاهيم العميقة التي تحتلُّ مكانة محورية في تفكيرنا الفكري المعاصر، حيث تمتد جذورها في دعوات الحوار والتفاعل بين الأمم والشعوب. وهذه الفكرة لم تقتصر على العوالم الفكرية أو الأكاديمية فقط، بل انتشرت عبر الفضاءات الثقافية والعلمية التي جمعت بين مفكرين وباحثين، ومؤسسات من مختلف الأقطار العربية. وعلى مدار السنوات، تجسّدت هذه الفكرة في العديد من الندوات والمؤتمرات التي نُظِّمت في مختلف البلدان العربية، حيث كانت كل فعالية تُمثِّل حلقة من حلقات التواصل الحضاري الفكري.
لقد كانت هذه الفعاليات مساحة للمراجعة الفكرية، حيث يتمُّ عبرها تناول القضايا الحضارية والإشكاليات المعاصرة، في محاولة لتجاوز التوترات والانقسامات بين الثقافات المتباينة. وقد حملت هذه المؤتمرات، التي شملت حوارات متنوِّعة بين العلماء والمفكرين، رسالة واحدة: أن التعارف هو جسر للتواصل والتفاهم بين الحضارات.
وكانت الجزائر من أكثر البلدان التي شهدت حضورًا ملحوظًا لفكرة تعارف الحضارات. حيث نُظِّمت عدَّة مؤتمرات وندوات متتالية أكَّدت على ضرورة فهم العلاقات بين الحضارات. فمن ندوة «الحضارات بين الحوار والتصادم والتعارف» في وهران «2013 م»، إلى الملتقى الدولي الرابع عشر «التغيير الحضاري وتحدياته» في أدرار «2012 م»، وصولًا إلى ندوة «الحضارة الإسلامية من الخصوصية إلى الكونية» في الأغواط «2019 م». وبهذا نلاحظ أن الجزائر كانت دائمًا في صدارة الفكر الذي يدعو إلى الانفتاح على الآخر والتفاهم بين الثقافات المتنوِّعة.
أما مصر، فهي البلد الذي يحمل في قلبه عبق تاريخ طويل من التواصل الثقافي والفكري، وقد تجسَّد ذلك بوضوح في العديد من الفعاليات الفكرية، أبرزها مؤتمر «تعارف الحضارات» في الإسكندرية «2011 م». وكانت القاهرة أيضًا مسرحًا لمؤتمر «الأزهر والغرب: حوار وتواصل» «2009 م»، والذي سلّط الضوء على التفاعل بين الشرق والغرب من خلال الفكر الإسلامي، مؤكِّدًا على دور الأزهر الشريف كمركز حيوي للحوار الحضاري. كذلك، كانت مؤتمرات مصر تحمل في طيَّاتها رسالة تتجاوز حدود الجغرافيا السياسية نحو رؤية شاملة تهدف إلى بناء جسور من التفاهم بين مختلف الأمم والشعوب.
وكانت الأردن - وبفضل موقعها الاستراتيجي ومؤسساتها الفكرية - مكانًا بارزًا لتنظيم العديد من الندوات التي ناقشت قضايا التعارف بين الحضارات، حيث تمّ التركيز على دور الأمة العربية في بناء الحضارة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، تمَّ تنظيم مؤتمر «نحو إسهام عربي إسلامي في الحضارة الإنسانية المعاصرة» في عمّان «2007 م»، بالإضافة إلى المؤتمر الذي انعقد في الطفيلة (2018) تحت عنوان: «حوار الحضارات والثقافات: الإرهاب آفة العصر»، الذي سلّط الضوء على دور الحوار الحضاري في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم في العصر الحديث.
كما شهدت السعودية وسوريا والعراق أيضًا حضورًا مهمًّا لفكرة تعارف الحضارات، لكن بطابع خاص. ففي الرياض سنة «2002 م» كان «الإسلام وحوار الحضارات» محورًا مهمًّا في ندوة نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز العامة. أما في دمشق عام «2008 م» فقد حضرت الفكرة في ملتقى معهد الفتح الإسلامي الذي تمَّ بالتعاون مع جامعة هاتفورد سيمنري الكاثوليكية الأمريكية. ومن جهة أخرى، نُظِّم في كربلاء سنة «2017 م» مؤتمر «الاعتدال في الدين والسياسة»، الذي قُدِّمت فيه ورقة بحثت دور التعارف الحضاري في إشاعة ثقافة الاعتدال في المجتمعات.
وكانت المغرب وألمانيا أيضًا مسرحًا لحضور فكرة تعارف الحضارات في فعاليات متعدِّدة. فقد شهدت مدينة وجدة «2018 م» الملتقى الدولي الرابع «ترجمة النصوص الدينية.. خطوة نحو معرفة الآخر»، الذي نظَّمه مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. أما في ألمانيا سنة (2022) فقد تمَّ تنظيم مؤتمر عن بُعد بعنوان «التربية على التسامح وتجسيد ثقافة العيش المشترك» بواسطة المركز الديمقراطي العربي، وهو مثال حي على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر فكر الحوار بين الحضارات.
من خلال استعراض هذه الفعاليات الفكرية التي حضرت فيها فكرة تعارف الحضارات، يمكن استخلاص عدة تأملات فلسفية ذات مغزى:
1- تجسّدُ هذه الفعاليات تأكيدًا على أن الحوار الحضاري ليس حدثًا عابرًا، بل هو مسار مستمر يزداد عمقًا مع مرور الوقت، ويُعزِّز من تماسك المجتمعات على اختلاف ثقافاتها.
2- تأكَّد لنا أن الحوار يأخذ أشكالًا متعدِّدة: دينية، ثقافية، سياسية وفلسفية، مما يعكس تعدُّدية التفكير وثراءه في مواجهة التحديات المعاصرة.
3- كل هذه الفعاليات تُبرز أهمية اللقاء المشترك بين الثقافات المختلفة، فلا يمكن أن يتمَّ بناء حضارة إنسانية مستدامة إلَّا من خلال الاحترام المتبادل والتفاهم العميق بين مختلف الأمم.
ليست الأفكار العظيمة بمنأى عن النقد، بل إن عافيتها الفكرية تُقاس أحيانًا بقدرتها على استدعاء الأسئلة والاعتراضات. ولأنّ «تعارف الحضارات» ليس مجرّد شعار أو رؤية مثالية، بل هو مشروع فكري يبتغي التكامل، كان من الطبيعي أن يُثير حوله طيفًا من القراءات الناقدة، بعضها نابع من اختلاف منهجي، وبعضها من تمثّلات سابقة لفهم العلاقة بين الحضارات.
في هذا السياق، يُخصّص الأستاذ زكي الميلاد الفصل السابع من كتابه للوقوف عند هذه الآراء الناقدة، لا ليُقابلها بردود انفعالية أو تبريرية، بل ليناقشها في عمقها، ويُعيد تأويلها ضمن الأفق الذي يُريده لفكرته. إذ إنّ ما يميّز المشاريع الحيّة ليس اكتمالها، بل قابليتها للحوار والمراجعة والامتداد. ومن هنا، فإنّ تأمُّل هذا الفصل لا يتمُّ بوصفه لحظة دفاع، بل باعتباره تمرينًا على الإصغاء الفلسفي، ومناسبة لاختبار المفهوم في حقول الدلالة والسياق والواقعية.
فما طبيعة هذه الانتقادات؟ وكيف تعامل معها صاحب المشروع؟ وإلى أيِّ مدى استطاع أن يحوّل النقد إلى أداة لتعميق الرؤية لا تقويضها؟ تلك أسئلة نقف عندها، ونحن نلِج عتبة الفصل السابع، مستبصرين أن الاختلاف لا يلغي الإمكان، بل يوسّعه.
في مقاله نشرها الباحث الكويتي الدكتور أحمد البغدادي بتاريخ 5 مارس 2002 في صحيفة الاتحاد بعنوان «تعارف الحضارات»، رأى أنَّ الآية التي استند إليها زكي الميلاد تتعلَّق بالصراع التاريخي بين الأوس والخزرج، ولا يمكن تعميمها على فكرة التفاعل بين الحضارات. ووفقًا للبغدادي، فإن الآية جاءت في سياق نزاع داخلي بين قبيلتين في المدينة، ومن ثَمَّ لا صلة لها بمفهوم التعارف بين الحضارات. إلَّا أن زكي الميلاد ردَّ على هذا النقد بنقطتين أساسيتين:
أولًا: أشار الميلاد إلى أن الآية مُوجَّهة إلى «الناس» بشكل عام، وليس فقط للمؤمنين. هذه النقطة تعدّ أساسية في الرَّدِّ على البغدادي، حيث يُفهم من ذلك أن الخطاب القرآني لا يقتصر على فئة معيَّنة، بل يشمل جميع البشر بغض النظر عن دياناتهم أو ثقافاتهم. ومن ثَمَّ، فإن الآية تدعو إلى التعارف والتفاهم بين البشر جميعًا، مما يجعلها أكثر شمولية من أن تُقتصر على سياق قبلي ضيِّق أو نزاع داخلي.
ثانيًا: تطرَّق الميلاد إلى مسألة التفسير المتعدِّد للنصوص الدينية، مشيرًا إلى أن المفسرين القدماء، مثل القرطبي، قدّموا تأويلات تُركِّز على الصراع بين الأوس والخزرج، وهي تأويلات ترتبط بسياق تاريخي معيَّن. ولكن بالنظر إلى تعدُّد التفاسير عبر العصور، يجب أن يكون فهم الآية أكثر مرونة ويواكب التحوُّلات الثقافية والتاريخية. لذا، لا ينبغي أن نقتصر على التفسير التقليدي، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الفهم الأوسع الذي يتَّسع لكل الشعوب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وهكذا ومن خلال هذه الردود، يوضّح الميلاد أن مفهوم «تعارف الحضارات» لا يتوقَّف عند حدود الزمان أو المكان، بل هو دعوة مفتوحة للتفاعل بين مختلف المجتمعات البشرية.
في كتابه «الإسلام والحداثة» الصادر سنة (2005)، قدّم إدريس هاني نقدًا لمفهوم «تعارف الحضارات» كما صاغه زكي الميلاد، مؤسّسًا موقفه على تصوُّر يرى أن التعارف لا يكون بين الحضارات ككيانات كبرى تحكمها القوة والمصالح، بل بين وحدات اجتماعية جزئية تتحرَّك داخل حقل سوسيوثقافي مشترك. وهو إذ يرفض فكرة «تعارف الحضارات»، يقترح بديلًا عنها: «تعارف الثقافات»، لأن الثقافات - في نظره - أقرب إلى التفاعل، وأكثر استعدادًا للحوار من الحضارات التي غالبًا ما يسودها منطق الهيمنة. كما يرى إدريس هاني أن الحوار يسبق التعارف، إذ لا يمكن للكيانات المختلفة أن تتعارف من دون أن تدخل أولًا في دائرة الحوار والتفاوض والاعتراف المتبادل.
لكن زكي الميلاد، ردّ على هذا التصوُّر انطلاقًا من تأويل قرآني وإنساني شامل للآية الكريمة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [4] ، مُؤكِّدًا أن الخطاب موجّه إلى «الناس» عمومًا، وليس محصورًا في المؤمنين، ولا مقيّدًا بزمن معيَّن، ولا بمنظومات ثقافية محدَّدة. فالدعوة إلى التعارف تتجاوز الإطار الثقافي أو السوسيوثقافي، لتصل إلى مستوى الشعوب والقبائل، أي إلى الجماعات والمجتمعات الإنسانية بصفتها كيانات حيَّة فاعلة في التاريخ.
ويرى الميلاد أن مفردتي «شعوب» و«قبائل» تدلَّان على شمول المعنى، إذ تشملان الكيانات الصغرى والكبرى، مما يعني أن التعارف ليس مجرَّد تبادل بين ثقافات، بل هو فعل جماعي تنهض به المجتمعات والأمم، لا الرموز أو المفاهيم. وهو بذلك يخالف إدريس هاني في ترتيب الأولويات، حيث يعتبر أن «التعارف» هو الأساس الذي يُبنى عليه الحوار، لا العكس. فالتعارف، وفق الرؤية القرآنية، يُمثِّل اللحظة التأسيسية التي تسبق كل تواصل أو تفاهم أو تعاون، لأنه يُعيد تأسيس العلاقة مع الآخر على قاعدة المعرفة لا الشك، وعلى قاعدة الاعتراف لا التنازع.
وبذلك، يقدّم الميلاد تصوُّرًا فلسفيًّا للتعارف يتجاوز الرؤية الثقافية الضيِّقة نحو أفق إنساني واسع، يرى في التعارف ضرورة وجودية ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الشعوب لا مجرَّد نُخب ثقافية، داعيًا إلى إعادة بناء العلاقات الإنسانية لا على منطق الغلبة، بل على ميثاق الاعتراف والتلاقي والتفاهم العميق بين الذوات الجماعية المختلفة.
ولعله الأطول، وهو للباحث الجزائري الدكتور محمد بولروايح في كتابه «نظريات حوار وصدام الحضارات» الصادر بالجزائر سنة 2010 م. وقد صاغ بولروايح نقده لأطروحة «تعارف الحضارات» في ثلاث ملاحظات أساسية، يمكن تلخيصها كما يلي:
أولًا: يرى أن مفهوم «تعارف الحضارات»، على الرغم ممّا يحمله من دلالات أخلاقية وإنسانية، لم يغادر بعدُ أفق الفكرة المجرَّدة نحو التجسُّد في واقع العلاقات الدولية والثقافية. فهو - بحسبه - لا يزال رهين التنظير، ولم يُترجم إلى مشاريع عملية أو سياسات حضارية ملموسة.
ثانيًا: يذهب بولروايح إلى التشكيك في مدى أحقيّة زكي الميلاد في نسبة هذا المصطلح لنفسه، معتبرًا أن جذور المفهوم كامنة في كتابات عدد من المفكرين الذين سبقوه إلى طرح رؤى متقاربة، مما ينفي عن الميلاد - وفق هذا الرأي - صفة الإبداع أو السبق في التركيب المفاهيمي.
ثالثًا: ينسب بولروايح إلى زكي الميلاد اتّهامًا موجَّهًا إلى المفكر الفرنسي روجيه غارودي، بأنه انزاح من خطاب حوار الحضارات إلى خطاب يتمركز حول «الإنسان والغرب»، متهمًا إياه بشكل ضمني بتحريف المسار الفكري الذي كان يتبنَّاه.
غير أن زكي الميلاد، في مواضع قدّم جملة من الردود التي تُظهر وعيه بهذه المآخذ وتقديره لحساسية الموقف النقدي. فقد أوضح أن مفهوم «تعارف الحضارات» لا يزال في طور البناء المفهومي، وأن لحظة التنظير في تصوُّره هي لحظة تأسيس لا تقلُّ أهمية عن لحظة التطبيق، بل هي شرطه الأول. وهو، بهذا المعنى، لا يُغفل التحديات التي تعترض تنزيل الفكرة في المجال العملي، بل يعترف بها باعتبارها جزءًا من قدر المفكّر في زمن التمزُّقات الكونية.
أما فيما يخصُّ الادّعاء بعدم أصالة المفهوم، فقد دافع الميلاد عن فرادته التأليفية، مُشدِّدًا على أن ما قد يُوجد من شذرات أو إشارات سابقة، لم تكن تحمل هذا التوليف الدلالي بين «تعارف» و«حضارات»، وأن إغفال بولروايح لتحديد الأسماء والمرجعيات التي سبقته في هذا الباب، أوقعه في إطلاق عام لا يليق بمنهج البحث الأكاديمي، الذي يقتضي الدِّقَّة في النقل والصرامة في الإحالة.
وأخيرًا، فإن ما اعتبره بولروايح «اتّهامًا» لغارودي، لا يعدو - في نظر الميلاد - أن يكون عرْضًا لمسار فكري وتحوُّلاته، من دون أحكام قاطعة أو نوايا إقصائية. فهناك فارقٌ جوهري بين من يسرد الأحداث كوقائع ثقافية، وبين من يُصدر الأحكام أو يتورّط في خطاب الاتِّهام.
وهكذا، يبدو هذا الحوار النقدي بين بولروايح وزكي الميلاد مثالًا حيًّا على التوتُّر الخلّاق في الفكر العربي المعاصر، بين محاولات التأسيس ومطالب المساءلة، وبين طموح المفهوم وأسئلة التفعيل، وهو حوار لا يُقاس بمدى اتِّفاق الأطراف، بل بعمق القضايا التي يُثيرها وثراء الإشكاليات التي يُلامسها.
طرح الباحث المصري الدكتور محمد كمال الدين إمام «1946 - 2020 م» في مداخلته الموسومة «مصطلح تعارف الحضارات رؤية إسلامية.. حوار مع زكي الميلاد» والتي قدّمها في مؤتمر مكتبة الإسكندرية حول تعارف الحضارات «مايو 2011»، تساؤلًا علميًّا عميقًا حول التوازي المفهومي بين «تعارف الحضارات» كما صاغه زكي الميلاد، و«نظرية التواصل» كما بلورها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس.
وقد عبّر الدكتور إمام عن قلق معرفي مشروع من هذا التداخل المفهومي، مستوضحًا حدود التجاور بين مفهوم أصيل في المرجعية الإسلامية «التعارف»، وآخر منبثق من المنظومة الفلسفية الغربية الحديثة «التواصل». وهذا القلق لم يكن نابعًا من موقف رفض أو إنكار، بل من الحرص على عدم تمييع الخصوصيات المفهومية والانزلاق فيما يُعرف في الفكر الإسلامي المعاصر ب«التغرُّب المفهومي».
غير أن زكي الميلاد، وهو الذي صاغ مفهوم «تعارف الحضارات» في أفق قرآني وإنساني معًا، لم يرَ في هذا التجاور ما يدعو للريبة أو التوجُّس، بل اعتبره تَماسًّا خلَّاقًا بين حقول المعرفة، وفرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين المفاهيم لا تفكيكها. فبحسب الميلاد، التعارف والتواصل يتقاطعان في النقطة الأعمق للإنساني: العبور من الأنا إلى الآخر، غير أنهما يختلفان من حيث الانتماء الدلالي والمنهجي؛ فالتواصل ينتمي إلى حقل الفلسفة وبالأخص النظرية النقدية، بينما التعارف ينتمي إلى المجال الإنساني العام، حيث تتفاعل الجماعات والمجتمعات، لا النخب الأكاديمية وحدها.
وبهذه المقاربة، يدعو الميلاد إلى نزع الخوف من المفاهيم، وإلى النظر إليها بوصفها أدوات لبناء الإنسان، لا قوالب لصراعه. بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فيرى أن التجاور مع فكرة التواصل لم يكن تعبيرًا عن تأثُّره بهابرماس، بل كان مدفوعًا برؤية إستراتيجية تروم استقطاب الوعي الفكري العالمي نحو مفهوم التعارف، الذي ظلَّ - رغم أصوله القرآنية وامتداداته الإنسانية - مغيَّبًا أو مهمّشًا في النقاشات الكبرى.
ويُلفت زكي الميلاد النظر إلى مفارقة معرفية لافتة: فبينما حظي مفهوم «التواصل» الغربي بدراسات موسَّعة، ونقاشات فلسفية طويلة، واهتمام أكاديمي متزايد، ظل مفهوم «التعارف» الذي يتمتع بثراء أخلاقي وروحي أوسع، يعاني من التهميش المفهومي والإهمال التداولي. ومن ثمّ، فإن جعله يتجاور مع «التواصل»، ليس غاية في حدِّ ذاته، بل وسيلة لإعادة الاعتبار له، وإدخاله في مدار العناية العلمية والفكرية.
من بين القراءات التي سعت إلى مقاربة أطروحة «تعارف الحضارات» برزت دراسة الباحث العراقي قيس ناصر راهي، المنشورة أواخر سنة 2013 م في مجلة «دراسات تاريخية» الصادرة عن كلية التربية للبنات بجامعة البصرة، تحت عنوان: «أطروحة تعارف الحضارات عند زكي الميلاد: بُعدها السياسي ومرتكزها الفكري»، وقد ضمّنت هذه الدراسة جملة من الانتقادات التي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط أساسية:
1- أن نموذج التعارف، حتى إن صحّ، فإنه يصدق على المجتمعات في بدايات تشكّلها، لا على العالم الراهن الذي تجاوز طور القبائل والأعراق الضيِّقة، وأصبح يعيش تعدُّدية متقدِّمة.
2- أن فكرة تعارف الحضارات عند زكي الميلاد صيغت من منظور ديني أخلاقي، بعيد عن الواقع السياسي الدولي.
3- أن أطروحة الميلاد لا ترقى إلى مستوى أطروحة هنتنغتون، الذي قدّم تصوُّره انطلاقًا من فهمه العميق للواقع السياسي، بينما اكتفى الميلاد بتأمُّلات أخلاقية فيما «يجب أن يكون»، من دون وعي بما «هو كائن».
غير أن هذه الانتقادات، على ما يبدو، بُنيت على قراءة تجزيئية ومتوهَّمة، أسقطت على النص ما ليس فيه، وفسّرت أطروحة تعارف الحضارات خارج سياقها المفهومي والوظيفي.
ففي ردِّه على النقد الأول، يُؤكِّد زكي الميلاد أن الآية القرآنية ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [5] ليست خطابًا مُوجَّهًا لمرحلة تاريخية منصرمة، بل نداءٌ إنساني مفتوح، متجاوز للأزمان والأمكنة، موجّه إلى البشرية في امتدادها الكوني، لا في طورها البدائي. ف«التعارف» هنا ليس مجرَّد توصيف اجتماعي، بل غاية وجودية مستمرَّة، تسكن في صلب فلسفة الاجتماع الإنساني. ومن ثَمَّ، فإن القول بأن المفهوم تجاوزه الزمن يُعدُّ تجاهلًا لمقاصده الكونية، ولطبيعته التأسيسية في بناء العلاقة بين المختلفين.
أما فيما يخصُّ النقد الثاني، فيرى الميلاد أن الكاتب قد توهَّم شيئًا لم يُقَل، إذ أسقط على المفهوم بعدًا سياسيًّا لم يُرِدْهُ الميلاد إطلاقًا، ولم يلمّح إليه. ف«تعارف الحضارات» ليس مشروعًا لسياسة عالمية، بل هو تصوُّر حضاري إنساني، ينتمي إلى حقل الفكر والثقافة، لا إلى ميادين الجغرافيا السياسية وصراعات القوى الدولية. وهذا ما بيّنه الميلاد بوضوح في كتابه «المسألة الحضارية» حيث وضع المفهوم في إطار مشروع فلسفي ثقافي، لا في إطار أجندة سياسية أو تحليل جيوستراتيجي.
أما النقد الثالث، فقد بُني على مقارنة تعسفية ومجحفة بين أطروحتين لا تنتميان إلى النسق نفسه، ولا تتقاطعان في الحقول ذاتها: أطروحة هنتنغتون التي هي تنظير لصدام الحضارات وفق منطق القوة والمصلحة، وأطروحة زكي الميلاد التي هي تأمُّل في إمكان قيام خطاب إنساني بديل، ينزع نحو التواصل والتفاهم. ومن ثَمَّ، فإن مفارقة «ما هو كائن» عند هنتنغتون و«ما يجب أن يكون» عند الميلاد ليست تُهمة، بل هي تمايز في المنهج والرؤية. فهنتنغتون صاغ رؤية سياسية تعبوية، بينما الميلاد قدّم تصوُّرًا أخلاقيًّا حضاريًّا، لا علاقة له بالصراع الجيوسياسي. وعليه فإن اتِّهام زكي الميلاد بعدم الفهم السياسي ليس إلَّا تعبيرًا عن إسقاط غير مبرَّر، ورغبة في حشر المفهوم في حقل لا ينتمي إليه.
وهكذا، فإن ما جاء به الباحث قيس راهي لم يكن سوى تأويلات لعلها متعجِّلة، بنيت على فرضيات غير راسخة، حمَّلت أطروحة تعارف الحضارات ما لا تحتمل، وقرأت نصوص الميلاد خارج أفقها الفكري والإنساني. ولذا، فإن ردّ زكي الميلاد على هذه الانتقادات لم يكن دفاعًا شخصيًّا، بل تفنيدًا فلسفيًّا دقيقًا يكشف عن عمق التباس القراءة، ويدعو إلى ضرورة التفريق بين الخطاب الأخلاقي الحضاري، والخطاب السياسي الأداتي، وعدم الخلط بينهما في مقام النقد.
يندرج هذا النقد ضمن قراءة اجتهادية قدّمها الباحثان العراقيان لقمان بهاء الدين أحمد والدكتور عُثمان محمد غريب في دراستهما الموسومة «الضوابط الأصولية للعلاقة بين الحضارات.. دراسة مقاصدية»، المنشورة سنة 2019 م. وفي هذا السياق، طرحا ثلاث نظريات تمثّل أوجه العلاقة بين الحضارات: نظرية الحوار، ونظرية الصدام، ونظرية تعارف الحضارات، التي اعتبراها رؤية جديدة وجديرة بالاعتبار، لا لحداثتها فحسب، بل لرسوخها في البنية المعرفية القرآنية، حيث تستمدُّ مشروعيتها وأصالتها من مقاصد النص التأسيسي الأول.
ومن منظور مقاصدي، يرى الباحثان أن التعارف يُشكِّل المقصد الأسمى للآية القرآنية الجامعة ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [6] ، من دون أن يُلغي هذا المقصد غيره من المقاصد المكمّلة كالتدافع، والتعاون، والتجادل. بيد أن التعارف، في أفقهما التأويلي، هو المبدأ المُقدّم، والمنطلق الذي تُؤسّس عليه باقي أشكال العلاقة. فهو ليس مجرَّد إمكان ضمن إمكانات، بل هو الترجمة الأخلاقية الأسمى للوجود المشترك بين الكيانات الحضارية.
وقد بيّن الباحثان أن جميع الأشكال التي حكمت العلاقات بين الحضارات عبر التاريخ - من صراع وتدافع وتحالف - كانت حاضرة بالفعل، غير أن التعارف يبقى الصيغة الأرقى والأقوم في أفق التمدّن الإنساني، لأنه وحده الكفيل بتشييد صرح التعايش السلمي، وترسيخ قيم التسامح، وتعميق إمكانات التشارك الحضاري. فالتعارف، من هذا المنظور، ليس شعارًا أخلاقيًّا مجرَّدًا، بل هو فعل تأصيلي ينزع نحو تأسيس ميثاق حضاري جامع، يتجاوز ثنائيات الهيمنة والخضوع، ويتَّجه نحو إنسانية مشتركة تسكنها روح الاعتراف المتبادل.
في سياق الاشتباك المفاهيمي حول فكرة «تعارف الحضارات»، نشر الباحث المغربي عبد الكريم القلالي دراسة بعنوان: «التعارف الحضاري في التراث العربي الإسلامي بين التنظير والممارسة»، ضمن العدد الثاني من مجلة تحالف الحضارات «يناير 2023 م». وقد أثار القلالي في مداخلته جملة من التحفُّظات على أطروحة زكي الميلاد، مُتَّخذًا من المفاضلة بين مفهومي الحوار والتعارف مدخلًا نقديًّا، حيث صوَّر أن الحوار في رؤية الميلاد أرقى مرتبةً من التعارف، لما ينطوي عليه من انفتاح وجداني وتفاعل عقلاني وتكافؤ في المقامات، بخلاف التعارف الذي يظل - في تقديره - محصورًا في مجرَّد رفع الجهل بحضارة الآخر، أي محصورًا في دائرة المعرفة الأدنى.
لكن زكي الميلاد، إذ تلقَّى هذا النقد، اعتبره مُفرَّغًا من دِقَّة التمييز الاصطلاحي، حيث رأى أن الناقد يُصرّ على الفصل بين «التعارف الحضاري» و«تعارف الحضارات»، من دون أن يُقدِّم حيثيات مفهومية كافية لهذا التمايز. وفي معرض ردِّه، سجّل الميلاد أن النزعة النقدية لدى القلالي لا تسعى إلى الإنصاف المعرفي، بقدر ما تنزع إلى مجادلة خلافية، يغيب فيها قصد الحقيقة ويحلُّ محلَّه افتعال الاختلاف.
كما توقَّف الميلاد عند تشديد القلالي على مفهوم الأمر بالمعروف بوصفه جوهر التعارف ومقصده الأصيل، وهو تأويل لم يرفضه الميلاد من حيث المبدأ، بل أدخله ضمن الدلالة الموسعة لقوله تعالى: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ ، إلَّا أنه رفض اختزال التعارف فيه، كما لو كان الوجه الأوحد للغائية الحضارية.
وفي المُحصِّلة، يرى زكي الميلاد أن هذا النوع من النقد يشكّل انزياحًا عن الأصول إلى الفروع، وأنه يجنح إلى انتقائية غير موضوعية في تلقِّي نصوصه، حيث تُقتبس أفكاره لا من باب الحوار المعرفي البنّاء، بل من باب تقطيع السياقات وتشويه المقاصد.
وهكذا، فإن هذا النقد يطرح أمامنا سؤالًا فلسفيًّا أعمق: هل العلاقة بين المفاهيم من قبيل التعارف والحوار هي علاقة تراتبية في القيمة، أم علاقة جدلية في الوظيفة؟ وهل مقصد «التعارف» يمكن أن يُردَّ إلى معنى واحد حصري، أم أنه بنية دلالية مفتوحة تحتمل مراتب متعدِّدة من التواصل، تبدأ بالمعرفة ولا تنتهي بالحوار والأمر بالمعروف؟
وينتهي زكي الميلاد في هذا الفصل إلى تأكيد مبدئي لا غبار عليه: أن النقد، بما هو أفق مفتوح على المراجعة والتصحيح، يُمثِّل ضرورة من ضرورات الإبداع البشري، بل هو شرط إمكان كل فكر حي ومتجدِّد. إذ لا وجود لفكرة مطلقة في عصمتها، ولا لفرد متعالٍ على الفحص والمساءلة.
وعلى هذا الأساس، يستعرض الميلاد أبرز الملاحظات النقدية التي وُجّهت إلى أطروحة تعارف الحضارات، فيُسجِّل أن معظمها قد انشغل بالتفاصيل والجزئيات، وغفل عن الرؤية الكلية للفكرة، أو عن طابعها التأسيسي الذي يربط بين القيم الأخلاقية وأهداف التواصل الإنساني. فكأنّ هؤلاء النُّقّاد - رغم نواياهم المختلفة - لم يتعاملوا مع «تعارف الحضارات» كفلسفة قِيمية ذات أفق إنساني شامل، بل كخطاب يمكن مجازاته من داخل متنه أو وفق سياقات انتقائية محدَّدة.
وفي المقابل، يُبرز الميلاد اتِّساع دائرة المؤيدين لهذا المفهوم، اتِّساعًا لا يقتصر على الكمّ العددي، بل يتنوَّع في التخصُّصات والآفاق الثقافية والجغرافية، ويشهد، منذ الإعلان عنه سنة 1997 م، تراكمًا معرفيًّا وتواصليًّا أخصب، يشمل أجيالًا من الباحثين والمفكرين، ويخترق جغرافيات متعدِّدة، من المشرق إلى المغرب.
غير أن الإنصاف الفكري - كما يشير الميلاد - يقتضي الاعتراف بأن للناقدين دورًا لا يُستهان به، فهم يساهمون - وإنْ بغير قصد أحيانًا - في تطوير النظرية، عبر تفعيل دينامية التفاعل معها، وفي اختبار قدرتها على الصمود أمام المساءلة، مما يمنحها نضجًا وتراكمًا نوعيًّا بمرور الزمن.
وهكذا، يتبدّى هذا الفصل كتأمُّل فلسفي في وظيفة النقد وجدليته، وفي العلاقة المتوتِّرة بين الكلّيات والجزئيات في قراءة المبادئ، داعيًا إلى تجاوز التجزئة المفهومية نحو استحضار المعنى الكلي للفكرة، بما يليق بمقامها الحضاري وغايتها الإنسانية.
إن قراءة كتاب «تعارف الحضارات: سيرة الفكرة وكيف تطوَّرت» لا تقودنا إلى خاتمة مغلقة، بل تفتح أمامنا أفقًا فلسفيًّا متجدِّدًا، يُحرّض على إعادة تشكيل الرؤية إلى العالم، والانتقال من منطق الهيمنة والصراع إلى منطق التعارف والائتلاف. فالفكرة التي قدّمها الأستاذ زكي الميلاد لا تُمثِّل ردّ فعل عابر على تحوّلات السياسة الدولية، بل هي إعادة تأصيلٍ معرفي وأخلاقي لعلاقة الإنسان بالآخر، في أزمنةٍ يغدو فيها الإنصات ضربًا من ضروب المقاومة الثقافية، والتسامح ممارسة فكرية راقية.
لقد صاغ الميلاد مشروعه بوصفه انزياحًا إبستمولوجيًّا عن منطق التمركز الحضاري، ودعوةً لتجاوز الثنائية القاتلة: «نحن - الآخر»، من خلال استحضار روح قرآنية تُؤمن بأن «التعارف» ليس مجرَّد تفاعل، بل هو شرط أنطولوجي لوجود الإنسان في العالم، ولبناء الوعي بوحدة المصير الإنساني.
ومع ذلك، فإن هذا المشروع، في رصانته الأولى، لا يُغلَق على ذاته، ولن يُغلق بإذن الله، بل يدعو إلى مواصلة التفكير، وإلى إعادة استكشاف آفاقه الممكنة. ويُمكن في هذا السياق تصوُّر عدد من المسارات الفلسفية والمعرفية التي يُمكن أن يطوّر بها المفكر زكي الميلاد - أو من يبتغي السير على نهجه - هذا المفهوم إلى فضاءات أرحب:
أولًا: أفق الجماليات التعارُفية: إن الفن والأدب والموسيقى تفتح للمخيال البشري سُبلًا للفهم غير العدائي. وإن تطوير هذا الأفق يُعيد للتعارف بُعده الوجداني والذوقي، ويجعل من الجمال لسانًا مشتركًا بين الثقافات والحضارات.
ثانيًا: أفق التعارف في الفضاء الرقمي: إذ إن العالم الافتراضي ألغى الحدود التقليدية وخلق هُويات هجينة تتطلَّب أطرًا جديدة للتفاعل تقوم على الاحترام، والخصوصية، والتعدُّد. وعليه فالتعارف هنا يتحوَّل من لقاء وجهًا لوجه إلى تفاعل شبكي واسع النطاق.
ثالثًا: أفق تعارف الأديان من الداخل: لا بوصفها عقائد متنازعة، بل بوصفها ضمائر روحية متجاوبة تتقاطع في نداءاتها الأخلاقية الكبرى. ويمكن لهذا الأفق أن يُفعّل المشترك الإيماني ليكون منصَّة لبناء السلام الروحي، والأخلاق العالمية، والعيش المشترك.
رابعًا: أفق تعارف الهامش والمركز: حيث يُستعاد الصوت المنسيّ للشعوب والثقافات المهمشة. وذلك أن التعارف الحقيقي لا يتمُّ بين القوى المهيمنة فقط، بل حين يصغي المركز لصوت الهامش، ويعترف بشرعية الروايات الأخرى للتاريخ.
خامسًا: أفق التربية التعارفية: عبر إدماج هذا المفهوم في المناهج التعليمية، ليس كدرس معرفي فقط، بل كمنهج حياة يُعلّم الناشئة كيف يتعاملون مع التعدُّد، وكيف يُعيدون التفكير في الاختلاف بوصفه إمكانًا لا تهديدًا.
سادسًا: أفق العقل التعارفي العابر للتخصُّصات: حيث يُمكن دمج التعارف في صلب العلوم الاجتماعية، والاقتصاد، والتقنيات، وعلوم الأعصاب، لتشكيل «عقل كوني» جديد يقرأ العالم بتعقيداته، ويقترح حلولًا تتجاوز التجزئة المعرفية.
سابعًا: أفق الكوسموبوليتية الروحية الصوفية: إذ يُستعاد البعد الروحي للتعارف من خلال انفتاح صادق على التجربة الصوفية، التي لطالما شكّلت في عمقها دعوة إلى محبَّة الإنسان كوجه من وجوه الحق، وإلى التلاقي في حضرة المعنى لا في ساحة الخصام. فالتصوُّف، بما يحمله من عمقٍ في معرفة الذات وسموٍّ في النظر إلى الآخر، يمكن أن يُشكّل أرضية خصبة لتعزيز تعارف يتجاوز الظواهر إلى الجوهر، ويجعل من العرفان مدخلًا إلى الكونية الرحيمة، لا الكونية الاستعلائية.
إن هذه الآفاق - وربما يوجد غيرُها - لا تُمثِّل مجرَّد تطوُّرات هامشية، بل هي توسُّعات ضرورية لفكرة بدأت جنينًا في الحقل العربي المعاصر، لكنها تحمل في جوهرها قابلية للتحوُّل إلى رؤية استراتيجية إنسانية شاملة.
وما يزال مشروع زكي الميلاد، في عمقه القرآني والفلسفي، مشروعًا حيًّا، قابلًا للامتداد والتجدُّد، وواعدًا بأن يكون من أكبر الإسهامات العربية في الفكر الإنساني المعاصر. ف«تعارف الحضارات» كما أبدع الأستاذ الميلاد، ليس فقط ميلادًا لفكرة، بل ميلادٌ لرؤية كونية، تؤنسنها القيم، وتُوحِّدها المسؤولية، وتُصغي فيها الذات إلى صدى الآخر باعتباره وجهًا آخر من وجوه الحقيقة.
















